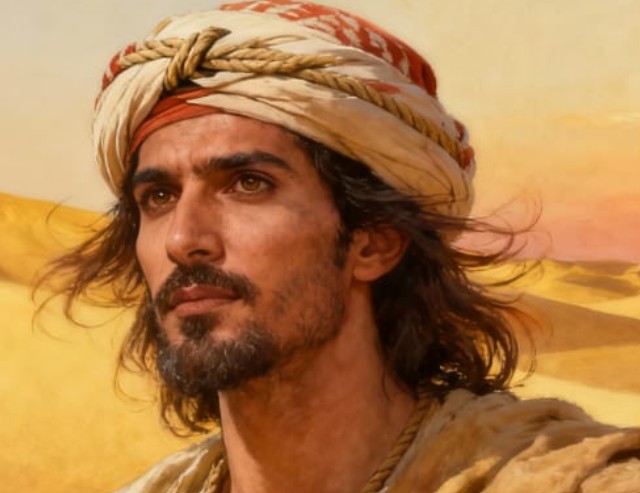
اِمْرُؤُ القَيْسِ بنُ حُجْرِ الكِنْدِيُّ (صورة رمزية)
تُعدّ معلقة امرئ القيس من أبرز أعمال الشعر الجاهلي، حيث يصف الشاعر أطلاله وحبه ورحلاته ووصف الخيل والغيث بأسلوب بلاغي فائق. تحتوي القصيدة على حوالي 80 بيتًا مع حواشي تفسيرية للمفردات والمعاني. تعرف على المزيد عن امرئ القيس.. تعرف على المزيد عن امرئ القيس.
إرشادات للقراءة
إظهار
إرشادات للقراءة
التنقل بين الأبيات والحواشي:
1. [1] رابط الحاشية (باللون الأحمر الداكن): انقر على الرقم بجانب البيت (مثل [1]) لفتح نافذة منبثقة تحتوي على تفسير المفردات والمعاني.2. [1]↴ رابط التنقل (باللون الأزرق): انقر على الرقم مع السهم (مثل [1]↴) للانتقال مباشرة إلى الحاشية في قسم "الحواشي التفسيرية" أسفل الجدول. سيظهر البيت المرتبط بنقطة حمراء وامضة لمدة 6 ثوانٍ.
3. ⤴[1] رابط العودة (باللون الأحمر الداكن): في قسم الحواشي، انقر على الرقم مع السهم التصاعدي (مثل ⤴[1]) للعودة إلى البيت في جدول القصيدة، مع ظهور نقطة حمراء وامضة لمدة 6 ثوانٍ.
استخدام النافذة المنبثقة:
عند النقر على رابط الحاشية [1]، تظهر نافذة تحتوي على:
- تفسير المفردات (مثل: "الهدى: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم").
- شرح البيت مع صور فنية إن وجدت.
- زر "نسخ" لنسخ محتوى الحاشية.
- زر "×" أو النقر خارج النافذة لإغلاقها.
اضغط مفتاح Escape لإغلاق النافذة بسرعة
إظهار وإخفاء الحواشي التفسيرية:
لعرض أو إخفاء قسم "الحواشي التفسيرية" أسفل القصيدة:
- انقر على زر "إظهار الحواشي" لعرض القسم الذي يحتوي على جميع التفسيرات التفصيلية للأبيات.
- عند عرض القسم، يتم التمرير تلقائيًا إليه بسلاسة لتسهيل الوصول.
- انقر على زر "إخفاء الحواشي" لإخفاء القسم، مما يقلل من الازدحام البصري في الصفحة.
- رابط العودة (أحمر داكن): في الحواشي، انقر على الرقم مع السهم (⤴[1]) للعودة إلى البيت في جدول القصيدة، مع نقطة حمراء وامضة لـ 6 ثوانٍ.
النص الكامل للقصيدة
| ١. | قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ | بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُول فَحَوْملِ[1][1] |
| ٢. | فَتُوْضِحَ فَالمِقْراةِ لمْ يَعْفُ رَسْمُها | لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وشَمْألِ[2][2] |
| ٣. | تَرَى بَعَرَ الأرْآمِ فِي عَرَصَاتِهَا | وَقِيْعَانِهَا كَأنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ[3][3] |
| ٤. | كَأنِّي غَدَاةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا | لَدَى سَمُرَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ[4][4] |
| ٥. | وُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عَلَّي مَطِيَّهُمُ | يَقُوْلُوْنَ:لاَ تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَمَّلِ[5][5] |
| ٦. | وإِنَّ شِفائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ | فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ؟[6][6] |
| ٧. | كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا | وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ[7][7] |
| ٨. | إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنْهُمَا | نَسِيْمَ الصَّبَا جَاءَتْ بِرَيَّا القَرَنْفُلِ[8][8] |
| ٩. | فَفَاضَتْ دُمُوْعُ العَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً | عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِي مِحْمَلِي[9][9] |
| الجزء الثاني: ثم انتقل إلى ذكر أيام اللهو والغزل مع الحبيبات، ضمن ثلاثة وعشرين بيتًا من القصيدة | ||
| ١٠. | ألاَ رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ | وَلاَ سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ[10][10] |
| ١١. | ويَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَي مَطِيَّتِي | فَيَا عَجَباً مِنْ كورها المُتَحَمَّلِ[11][11] |
| ١٢. | فَظَلَّ العَذَارَى يَرْتَمِيْنَ بِلَحْمِهَا | وشَحْمٍ كَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ[12][12] |
| ١٣. | ويَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ | فَقَالَتْ:لَكَ الوَيْلاَتُ!،إنَّكَ مُرْجِلِي[13][13] |
| ١٤. | تَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبِيْطُ بِنَا مَعاً: | عَقَرْتَ بَعِيْرِي يَا امْرأَ القَيْسِ فَانْزِلِ[14][14] |
| ١٥. | فَقُلْتُ لَهَا:سِيْرِي وأَرْخِي زِمَامَه | ولاَ تُبْعدِيْنِي مِنْ جَنَاكِ المُعَلَّلِ[15][15] |
| ١٦. | فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ | فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ[16][16] |
| ١٧. | إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ | بِشَقٍّ،وتَحْتِي شِقُّهَا لَمْ يُحَوَّلِ[17][17] |
| ١٨. | ويَوْماً عَلَى ظَهْرِ الكَثِيْبِ تَعَذَّرَتْ | عَلَيَّ، وَآلَتْ حَلْفَةً لم تَحَلَّلِ[18][18] |
| ١٩. | أفاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ | وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزمعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي[19][19] |
| ٢٠. | وَإنْ تكُ قد ساءتكِ مني خَليقَةٌ | فسُلّي ثيابي من ثيابِكِ تَنْسُلِ[20][20] |
| ٢١. | أغَرَّكِ مِنِّي أنَّ حُبَّكِ قَاتِلِي | وأنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِي القَلْبَ يَفْعَلِ؟[21][21] |
| ٢٢. | وأنك قسمت الفؤاد، فنصفه | قتيل، ونصف بالحديد مكبل[22][22] |
| ٢٣. | وَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاكِ إلاَّ لِتَضْرِبِي | بِسَهْمَيْكِ فِي أعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ[23][23] |
| ٢٤. | وبَيْضَةِ خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَا | تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَلِ[24][24] |
| ٢٥. | تَجَاوَزْتُ أحْرَاساً إِلَيْهَا وَمَعْشَراً | عَلَّي حِرَاصاً لَوْ يُسِرُّوْنَ مَقْتَلِي[25][25] |
| ٢٦. | إِذَا مَا الثُّرَيَّا فِي السَّمَاءِ تَعَرَّضَتْ | تَعَرُّضَ أَثْنَاءَ الوِشَاحِ المُفَصَّلِ[26][26] |
| ٢٧. | فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَا | لَدَى السِّتْرِ إلاَّ لِبْسَةَ المُتَفَضِّلِ[27][27] |
| ٢٨. | فَقَالتْ:يَمِيْنَ اللهِ، مَا لَكَ حِيْلَةٌ، | وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ الغَوَايَةَ تَنْجَلِي[28][28] |
| ٢٩. | خَرَجْتُ بِهَا تمْشِي تَجُرُّ وَرَاءَنَا | عَلَى أَثَرَيْنا ذيل مِرْطٍ مُرَحَّلِ[29][29] |
| ٣٠. | فَلَمَّا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَحَى | بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَنْقَلِ[30][30] |
| ٣١. | هَصَرْتُ بِفَوْدَيْ رَأْسِهَا فَتَمَايَلَتْ | عَليَّ هَضِيْمَ الكَشْحِ رَيَّا المُخَلْخَلِ[31][31] |
| ٣٢. | إذا التفتت نحوي تضوّع ريحُها | نسيمَ الصَّبا جاءت بريّا القرنفُلِ[32][32] |
| الجزء الثالث: وبعد ذلك وصف الشاعر الحبيبة بأجمل الأوصاف، ضمن ثلاثة عشر بيتًا من المعلقة | ||
| ٣٣. | مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ | تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ[33][33] |
| ٣٤. | كَبِكْرِ المُقَانَاةِ البَيَاضَ بِصُفْرَةٍ | غَذَاهَا نَمِيْرُ المَاءِ غَيْرُ مُحَلَّلِ[34][34] |
| ٣٥. | تَصُدُّ وتُبْدِي عَنْ أسِيْلٍ وَتَتَّقي | بِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ[35][35] |
| ٣٦. | وجِيْدٍ كَجِيْدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ | إِذَا هِيَ نَصَّتْهُ وَلاَ بِمُعَطَّلِ[36][36] |
| ٣٧. | وفَرْعٍ يَزِيْنُ المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِمٍ | أثِيْثٍ كَقِنْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ[37][37] |
| ٣٨. | غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى العُلا | تَضِلُّ العِقَاصُ فِي مُثَنَّى وَمُرْسَلِ[38][38] |
| ٣٩. | وكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالجَدِيْلِ مُخَصَّرٍ | وسَاقٍ كَأُنْبُوبِ السَّقِيِّ المُذَلَّلِ[39][39] |
| ٤٠. | وَتُضْحِي فَتِيْتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِهَا | نَؤُومُ الضَّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضُّلِ[40][40] |
| ٤١. | وتَعْطُو بِرَخْصٍ غَيْرَ شَشْنٍ كَأَنَّهُ | أَسَارِيْعُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاويْكُ إِسْحِلِ[41][41] |
| ٤٢. | تُضِيءُ الظَّلامَ بِالعِشَاءِ كَأَنَّهَا | مَنَارَةُ مُمْسَى رَاهِبٍ مُتَبَتِّلِ[42][42] |
| ٤٣. | إِلَى مِثْلِهَا يَرْنُو الحَلِيْمُ صَبَابَةً | إِذَا مَا اسْبَكَرَّتْ بَيْنَ دِرْعٍ ومِجْوَلِ[43][43] |
| ٤٤. | تَسَلَّتْ عَمَايَاتُ الرِّجَالِ عَنْ الصِّبَا | ولَيْسَ فُؤَادِي عَنْ هَوَاكِ بِمُنْسَلِ[44][44] |
| ٤٥. | ألاَّ رُبَّ خَصْمٍ فِيْكِ أَلْوَى رَدَدْتُهُ | نَصِيْحٍ عَلَى تَعْذَالِهِ غَيْرِ مُؤْتَلِ[45][45] |
| الجزء الرابع: ثم تحدث عن الليل الطويل وشدة الهم، ضمن خمسة أبيات من القصيدة | ||
| ٤٦. | ولَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ | عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُوْمِ لِيَبْتَلِي[46][46] |
| ٤٧. | فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ | وأَرْدَفَ أَعْجَازاً وَنَاءَ بِكَلْكَلِ[47][47] |
| ٤٨. | ألاَ أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ ألاَ انْجَلِي | بِصُبْحٍ، وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَلِ[48][48] |
| ٤٩. | فَيَا لَكَ مَنْ لَيْلٍ كَأَنَّ نُجُومَهُ | بكل مُغار الفتل شُدّت بيذبل[49][49] |
| ٥٠. | كَأَنَّ الثُرَيّا عُلِّقَت في مَصامِها | بِأَمْرَاسِ كَتَّانٍ إِلَى صُمِّ جَنْدَل[50][50] |
| الجزء الخامس: فانتقل إلى وصف الفرس والصيد في رحلة الصحراء، ضمن ثمانية عشر بيتًا من المعلقة | ||
| ٥١. | وَقَدْ أغْتَدِي والطَّيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا | بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ[51][51] |
| ٥٢. | مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً | كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ[52][52] |
| ٥٣. | كَمَيْتٍ يَزِلُّ اللَّبْدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ | كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بِالمُتَنَزَّلِ[53][53] |
| ٥٤. | مِسِحٍّ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَلَى الوَنى | أَثَرْنَ الغُبَارَ بِالكَدِيْدِ الْمُرَكَّلِ [54][54] |
| ٥٥. | عَلَى الذبل جَيَّاشٍ كأنَّ اهْتِزَامَهُ | إِذَا جَاشَ فِيْهِ حَمْيُهُ غَلْيُ مِرْجَلِ[55][55] |
| ٥٦. | يَزِلُّ الغُلاَمُ الخِفُّ عَنْ صَهَوَاتِهِ | وَيُلْوِي بِأَثْوَابِ العَنِيْفِ المُثَقَّلِ[56][56] |
| ٥٧. | دَرِيْرٍ كَخُذْرُوفِ الوَلِيْدِ أمَرَّهُ | تقلب كَفَّيْهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلِ[57][57] |
| ٥٨. | لَهُ أيْطَلا ظَبْيٍ، وَسَاقَا نَعَامَةٍ | وإِرْخَاءُ سَرْحَانٍ، وَتَقْرِيْبُ تَتْفُلِ[58][58] |
| ٥٩. | كَأَنَّ عَلَى الْمَتْنَيْنِ مِنْهُ إِذَا انْتَحَى | مَدَاكُ عَرُوسٍ أَوْ صَلايَةَ حَنْظَلِ[59][59] |
| ٦٠. | وبَاتَ عَلَيْهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ | وَبَاتَ بِعَيْنِي قَائِماً غَيْرَ مُرْسَلِ[60][60] |
| ٦١. | فَعَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ | عَذَارَى دَوَارٍ فِي مُلاءٍ مُذيّلِ[61][61] |
| ٦٢. | فَأَدْبَرْنَ كَالجِزْعِ المُفَصَّلِ بَيْنَهُ | بِجِيْدٍ مُعَمٍّ فِي العَشِيْرَةِ مُخْوِلِ[62][62] |
| ٦٣. | فَأَلْحَقَنَا بِالهَادِيَاتِ ودُوْنَهُ | جَوَاحِرُهَا فِي صَرَّةٍ لَمْ تُزَيَّلِ[63][63] |
| ٦٤. | فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَةٍ | دِرَاكاً، وَلَمْ يَنْضَحْ بِمَاءٍ فَيُغْسَلِ[64][64] |
| ٦٥. | وَظَلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ مِن بَيْنِ مُنْضِجٍ | صَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِيْرٍ مُعَجَّلِ[65][65] |
| ٦٦. | ورُحْنَا وَراحَ الطَّرْفُ ينفض رأسه | مَتَى تَرَقَّ العَيْنُ فِيْهِ تَسهَّلِ[66][66] |
| ٦٧. | كَأَنَّ دِمَاءَ الهَادِيَاتِ بِنَحْرِهِ | عُصَارَةُ حِنَّاءٍ بِشَيْبٍ مُرَجَّلِ[67][67] |
| ٦٨. | وأنت إِذَا اسْتَدْبَرْتَهُ سَدَّ فَرْجَهُ | بِضَافٍ فُوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ[68][68] |
| الجزء السادس: وختم الشاعر معلقته بوصف العاصفة والسيل الهائل، ضمن أحد عشر بيتًا من القصيدة | ||
| ٦٩. | أصاح تَرَى بَرْقاً أُرِيْكَ وَمِيْضَهُ | كَلَمْعِ اليَدَيْنِ فِي حَبِيٍّ مُكَلَّلِ[69][69] |
| ٧٠. | يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيْحُ رَاهِبٍ | أمال السَّلِيْطَ بالذُّبَالِ المُفَتَّلِ[70][70] |
| ٧١. | قَعَدْتُ لَهُ وصُحْبَتِي بَيْنَ حامر | وبَيْنَ إكام، بُعْدَمَا مُتَأَمَّلِي[71][71] |
| ٧٢. | فأَضْحَى يَسُحُّ المَاءَ عن كل فيقةٍ | يَكُبُّ عَلَى الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَهْبَلِ[72][72] |
| ٧٣. | وتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَةٍ | وَلاَ أُطُماً إِلاَّ مَشِيداً بِجِنْدَلِ[73][73] |
| ٧٤. | كَأَنَّ ذُرَى رَأْسِ المُجَيْمِرِ غُدْوَةً | مِنَ السَّيْلِ وَالغُثّاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ[74][74] |
| ٧٥. | كَأَنَّ أباناً فِي أفانين ودقه | كَبِيْرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ[75][75] |
| ٧٦. | وأَلْقَى بِصَحْرَاءِ الغَبيْطِ بَعَاعَهُ | نُزُوْلَ اليَمَانِي ذِي العِيَابِ المحملِ[76][76] |
| ٧٧. | كَأَنَّ سباعاً فِيْهِ غَرْقَى عَـــشِـــيَّــةً | بِأَرْجَائِهِ القُصْوَى أَنَابِيْشُ عُـــنْـــصَلِ[77][77] |
| ٧٨. | عَلَى قَطَنٍ، بِالشَّيْمِ، أَيْمَنُ صَوْبِهِ | وَأَيْسَرُهُ عَلَى السِّتَارِ فَيَذْبُل[78][78] |
| ٧٩. | وَمرّ عَلَى القَنَّانِ من نَفَيانِهِ | فَأَنْزَلَ مِنْهُ العُصْمَ مِنْ كُلِّ مَنْزِلِ[79][79] |
الحواشي التفسيرية
[1]
المفردات والمعاني:
السقط: منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه، والسقط أيضًا ما يتطاير من النار، والسقط أيضًا المولود لغير تمام، وفيه ثلاث لغات: سَقط وسِقط وسُقط في هذه المعاني الثلاثة.
اللوى: رمل يعوج ويلتوي.
الدخول: موضعان.
وحومل: موضعان.
الشرح: قيل: خاطب صاحبيه، وقيل: بل خاطب واحدًا وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنين؛ لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمع، فمن ذلك قول الشاعر سويد بن كراع العكلي: [الطويل]:فإن تزجراني يا بن عفان أنزجر ... وإن ترعياني أحم عرضًا ممنّعًا
خاطب الواحد خطاب الاثنين، وإنما فعلت العرب ذلك لأن الرجل يكون أدنى أعوانه اثنين: راعي إبله وراعي غنمه، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه، ويجوز أن يكون المراد به: قف قف، فإلحاق الألف أمارة دالة على أن المراد تكرير اللفظ كما قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ ارْجِعُون} [المؤمنون: ٩٩] المراد منه: أرجعني أرجعني أرجعني، جعلت الواو علمًا مشعرًا بأن المعنى تكرير اللفظ مرارًا، وقيل: أراد قفن على جهة التأكيد فقلب النون ألفًا في حال الوصل؛ لأن هذه النون تقلب ألفًا في حال الوقف فحمل الوصف على الوقف، ألا ترى أنك لو وقفت على قوله تعالى: {لَنَسْفَعَا} [العلق: ١٥] قلت: لنسفعًا؟ ومنه قول الأعشى: [الطويل]:وصلِّ على حين العشيات والضحى ... ولا تحمد المثرين والله فاحمدا
أراد فاحمدن فقلب نون التأكيد ألفًا، يقال بكى يبكي بكاء وبُكىً، ممدودًا ومقصورًا، أنشد ابن الأنباري لحسان بن ثابت شاهدًا له: [الوافر]:بكت عيني وحق لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل
فجمع بين اللغتين؛ يقول: قفا وأسعداني وأعيناني، أو قف وأسعدني على البكاء عند تذكري حبيبًا فارقته ومنزلًا خرجت منه، وذلك المنزل أو ذلك الحبيب أو ذلك البكاء بمنقطع الرمل المعوج بين هذين الموضعين.
[2]
المفردات والمعاني:
توضح: والمقراة موضعان وسقط اللوي بين هذه المواضع الأربعة.
الرسم: ما لصق بالأرض من آثار الدار مثل البعر والرماد وغيرهما. والجمع أرسم ورسوم.
شمأل: فيها ست لغات: شمال وشمأل وشأمل وشمول وشَمْل وشَمَل.
نسج الريحين: اختلافهما عليها وستر إحداهما إياها بالتراب وكشف الأخرى التراب عنها.
الشرح: قوله: لم يعف رسمه، أي لم يَنْمَحِ أثرها. يقول: لم ينمحِ ولم يذهب أثرها؛ لأنه إذا غطته إحدى الريحين بالتراب كشف الأخرى التراب عنها، وقيل: بل معناه لم يقتصر سبب محوها على نسج الريحين بل كان له أسباب منها هذا السبب ومر السنين وترادف الأمطار وغيرها، وقيل: بل معناه لم يعف رسم حبها من قلبي وإن نسجتها الريحان، والمعنيان الأولان أظهر من الثالث وقد ذكرها كلها أبو بكر ابن الأنباري.
[3]
المفردات والمعاني:
الأرآم: الظباء البيض الخالصة البياض، واحدها رئم، بالكسر، وهي تسكن الرمل.
عرصات: في "المصباح": عرصة الدار ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلب وكلاب، وعرصات مثل سجدة وسجدات وعن الثعالبي كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة، وفي "التهذيب": وسميت ساحة الدار عرصة؛ لأن الصبيان يعرصون فيها أي: يلعبون ويمرحون.
قيعان: جمع قاع وهو المستوي من الأرض، وقيعة مثل القاع، وبعضهم يقول: هو جمع، وقاعة الدار ساحتها.
الفلفل: قال في القاموس: كهدهد وزبرج، حب هندي، ونسب الصاغاني، الكسر للعامة، وفي المصباح: الفلفل بضم الفاءين من الأبزار، قالوا: لا يجوز فيه الكسر.
الشرح: يقول: انظر بعينيك تر هذه الديار التي كانت مأهولة مأنوسة بهم خصبة الأرض، كيف غادرها أهلها وأقفرت من بعدهم أرضها وسكنت رملها الظباء، ونثرت في ساحاتها بعرها حتى تراه كأنه حب الفلفل في مستوى رحباتها. "هذا الشرح ليس للزَّوزَني"
[4]
المفردات والمعاني:
غداة: في "المصباح": والغداة الضحوة، وهي مؤنثة قال ابن الأنباري: ولم يسمع تذكيرها، ولو حملها حامل على معنى أول النهار جاز له التذكير، والجمع غدوات.
البين: الفرقة وهو المراد هنا، وفي "القاموس": البين يكون فرقة ووصلًا، قال الشارح: بان يبين بينًا وبينونة، وهو من الأضداد.
اليوم: معروف، مقداره، من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يراد باليوم الوقت مطلقًا، ومنه الحديث: "تلك أيام الهرج"، أي: وقته, ولا يختص بالنهار دون الليل.
تحملوا: واحتملوا بمعنى: أي ارتحلوا.
لدى: بمعنى عند.
سمرات: جمع سمرة، بضم الميم: من شجر الطلح.
الحي: القبيلة من الأعراب، والجمع أحياء.
نقف الحنظل: شقة عن الهبيد، وهو الحب، كالإنقاف والانتقاف، وهو، أي الحنظل، نقيف ومنقوف، وناقفهِ الذي يشقه.
الشرح: يقول: كأني عند سمرات الحي يوم رحيلهم ناقف حنظل، يريد وقف بعد رحيلهم في حيرة وقفة جاني الحنظلة ينقفها بظفره ليستخرج منها حبها، "هذا الشرح ليس للزَّوزَني".
[5]
المفردات والمعاني:
الوقوف: جمع واقف بمنزلة الشهود والركوع في جمع شاهد وراكع.
الصحب: جمع صاحب، ويجمع الصاحب على الأصحاب والصحب والصحاب والصحابة والصحبة والصحبان، ثم يجمع الأصحاب على الأصاحيب أيضًا ثم يخفف فيقال الأصاحب.
المطي: المراكب، واحدتها مطية، وتجمع المطية على المطايا والمطي والمطيات، سميت مطية؛ لأنه يركب مطاها أي ظهرها، وقيل: بل هي مشتقة من المطو وهو المد في السير، يقال: مطاه يمطوه، فسميت به لأنها تمد في السير.
أسىً: نصب أسىً؛ لأنه مفعول له.
الشرح: نصب وقوفًا على الحال، يريد قفا نبك في حال وقف أصحابي مطيهم علي، يقول: قد وقفوا عليّ أي: لأجلي أو على رأسي وأنا قاعد عند رواحلهم ومراكبهم، يقولون لي: لا تهلك من فرط الحزن وشدة الجزع وتجمل بالصبر، وتلخيص المعنى: أنهم وقفوا عليه رواحلهم يأمرونه بالصبر وينهونه عن الجزع.
[6]
المفردات والمعاني:
المهراق: والمراق: المصبوب، وقد أرقت الماء وهرقته وأهرقته أي صببته.
المعوّل: المبكى، وقد أعول الرجل وعوّل إذا بكى رافعًا صوته به، والمعول: المعتمد والمتكل عليه أيضًا.
العبرة: الدمع، وجمعها عبرات، وحكى "ثعلب" في جمعها العِبَر مثل بدرة وبِدَر.
الشرح: يقول: وإن برئي من دائي ومما أصابني وتخلصي مما دهمني يكون بدمع أصبّه ثم قال: وهل من معتمد ومفزع عند رسم قد درس، أو هل موضع بكاء عند رسم دارس؟ وهذا استفهام يتضمن معنى الإنكار، والمعنى عند التحقيق: ولا طائل في البكاء في هذا الموضع؛ لأنه لا يرد حبيبًا، ولا يجدي على صاحبه بخير، أو لا أحد يعول عليه ويفزع إليه في مثل هذا الموضع، وتلخيص المعنى: وإن مخلصي مما بي بكائي، ثم قال: ولا ينفع البكاء عند رسم دارس، أو ولا معتمد عند رسم دارس.
[7]
المفردات والمعاني:
الدأْبُ: والدأَبُ، بتسكين الهمزة وفتحها: العادة، وأصلها متابعة العمل والجد في السعي، دَأَبَ فلانٌ الشَّيءَ/ دَأَبَ فلانٌ على الشَّيءِ: لازمه واعتاده دون فتور، استمرّ وواظب عليه.
مستمرّان: في الحركة لا يتوقَّفان.
دأب: يدأب دأبًا ودئابًا ودءوبًا، وأدأبت السير: تابعته.
مأسَل: بفتح السين: جبل بعينه، ومأسِل، بكسر السين: ماء بعينه والرواية فتح السين.
الشرح: ومنها قول الشاعر عروة بن أذينة:وقَولي عسَى أن تَجْزِني الوُدَّ أَو تَرى …................. فتعب يوماً فكيف دأبي ودأبها
يقول: عادتك في حب هذه كعادتك من تينك، أي: قلة حظك من وصال هذه ومعاناتك الوجد بها كقلة حظك من وصالهما، ومعاناتك الوجد بهما، قوله: قبلها أي: قبل هذه التي شغفت بها الآن.
[8]
المفردات والمعاني:
ضاع الطيب: وتضوّع إذا انتشرت رائحته.
الريّا: الرائحة الطيبة.
الشرح: ومنه قول الشاعر أحمد شوقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم:بَكَ بَـشَّـرَ الـلَهُ السَماءَ فَزُيِّنَت وَتَـضَـوَّعَـت مِـسكاً بِكَ الغَبراءُ
يقول: إذا قامت أم الحويرث وأم الرباب فاحت ريح المسك منهما كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل ونشره. شبه طيب رياهما بطيب نسيم هبّ على قرنفل وأتى بريّاه، ثم لما وصفهما بالجمال وطيب النشر وصف حاله بعد بعدهما.
[9]
المفردات والمعاني:
الصبابة: رقة الشوق، وقد صبّ الرجل يصب صبابة فهو صَبٌّ، والأصل صبب فسكنت العين وأدغمت في اللام.
المحمل: حمالة السيف، والجمع المحامل، والحمائل جمع الحمالة.
الشرح: يقول: فسالت دموع عيني من فرط وجدي بهما وشدة حنيني إليهما حتى بلّ دمعي حمالة سيفي. ونصب صبابة على أنه مفعول له كقولك: زرتك طمعًا في برِّك، قال الله تعالى: {مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ} [البقرة: ١٩] أي: لحذر الموت، وكذلك زرتك للطمع في برِّك، وفاضت دموع العين مني للصبابة.
[10]
المفردات والمعاني:
ربّ: لغات: وهي رُبَّ ورَبَّ ورُبْ ورُبَ ثم تلحق التاء فتقول ربّة وربّت، وربّ موضوع في كلام العرب للتقليل وكم موضوع للتكثير، ثم ربما حملت رُبّ على كم في المعنى فيراد بها التكثير، وربما حملت كم على رب في المعنى فيراد بها التقليل.
السيّ: المثل: يقال هما سيان أي مثلان. ويجوز في يوم الرفع والجر، فمن رفع جعل ما موصولة بمعنى الذي، والتقدير: ولا سي اليوم الذي هو بدارة جلجل، ومن خفض جعل ما زائدة، وخفضه بإضافة سيّ إليه فكأنه قال: ولا سي يوم أي ولا مثل يوم.
دارة جلجل: غدير بعينه.
الشرح: يقول: رب يوم فزت فيه بوصال النساء وظفرت بعيش صالح ناعم منهن ولا يوم من تلك الأيام مثل يوم دارة جلجل، يريد أن ذلك اليوم كان أحسن الأيام وأتمها، فأفادت لا سيما التفضيل والتخصيص. وقال ابن دريد في كتاب البنين والبنات: دارة جلجل بين شعبى وبين حسلات وبين وادي المياه وبين البردان، وهي دار الضباب ممّا يواجه نخيل بني فزارة، وفي كتاب جزيرة العرب للأصمعي: دارة جلجل من منازل حجر الكندي بنجد. قال: دارة جلجل بالحمى ويقال بغمر ذي كندة، وقال عمرو بن الخثارم البجلي:وكنّا كأنّا يوم دارة جلجل ... مدلّ على أشباله يتهمهم
دارة جلجل هي حادثة تروى عن الشاعر الجاهلي امرئ القيس حدثت له مع صاحبة يوم "دارة جلجل" في بلاد نجد تبيّن كيف مكر بابنة عمه "عنيزة"، فأجبرها على أن تتجرد من لباسها، لينظر إليها وهي تخرج من الغدير مقبلة ومدبرة، حتى يمتع نظره برؤية جسدها العاري.
[11]
المفردات والمعاني:
العذراء من النساء: البكر التي لم تفتض، والجمع العذارى.
الكور: الرحل بأداته، والجمع الأكوار والكيران؛ ويروى: من رحلها المتحمل، المتحمل: الحمل.
فتح يوم: مع كونه معطوفًا على مجرور أو مرفوع وهو يومٌ أو يومٍ بدارة جلجل؛ لأنه بناه على الفتح لما أضافه إلى مبني وهو الفعل الماضي، وذلك قوله: عقرت، وقد يبنى المعرب إذا أضيف إلى مبني.
عقرت: جرحت، وأراد به ذبحت كما تبين لك في البيت السابق، وأصل العقر أن يعند أحدهم إلى قوائم الناقة، فيضربها بسيفه حتى لا تقوى على مقاومة الذابح لها.
الشرح: ومنه قوله تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} [الذاريات: ٢٣] ؛ فبنى مثل على الفتح مع كونه نعتًا لمرفوع لما أضافه إلى ما وكانت مبنية، ومنه قراءة من قرأ: {وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذ} [هود: ٦٦] بنى يوم على الفتح لما أضافه إلى إذ وهي مبنية وإن كان مضافًا إليه؛ ومثله قول النابغة الذبياني: [الطويل]:على حينَ عاتبت المشيب على الصبا ... فقلت ألما تصح والشيب وازع١
بنى حين على الفتح لما أضافه إلى الفعل الماضي؛ فضّلَ يوم دارة جلجل ويوم عقر مطيته للأبكار على سائر الأيام الصالحة التي فاز بها من حبائبه، ثم تعجب من حملهن رحل مطيته وأداته بعد عقرها واقتسامهن متاعه بعد ذلك. قوله: فيا عجبًا، الألف فيه بدل من ياء الإضافة، وكان الأصل فيا عجبي، وياء الإضافة يجوز قلبها ألفًا في النداء نحو يا غلامًا في يا غلامي، فإن قيل: كيف نادى العجب وليس مما يعقل؟ قيل في جوابه: إن المنادى محذوف، والتقدير: يا هؤلاء أو يا قوم اشهدوا عجبي من كورها المتحمل فتعجبوا منه، فإنه قد جاوز المدى والغاية القصوى؛ وقيل: بل نادى العجب اتساعًا ومجازًا، فكأنه قال: يا عجبي تعال واحضر فإن هذا أو إن إتيانك وحضورك. العجب: هو انفعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه، أو استطرافه، أو إنكاره ما يرد عليه ويشاهده.
[12]
المفردات والمعاني:
ظل: أصله ظلل، فأسكنت اللام الأولى بعد إسقاط حركتها، وأدغمت في الثانية، يقال: ظل زيد قائمًا إذا أتى عليه النهار وهو قائم، وبات زيد نائمًا إذا أتى عليه الليل وهو نائم.
يرتمين: يناول بعضهم بعضًا.
الْهُدَّاب: والهدب: اسمان لما استرسل من الشيء نحو ما استرسل من الأشفار من الشعر ومن أطراف.
والمدقس: الإبريسم، وقيل: هو الأبيض منه خاصة.
المفتل: المبرم من طاقين أو أكثر.
الشحم: السمن.
المفتل: المبرم من طاقين أو أكثر.
الشرح: المعنى يقول: ظل العذارى طوال نهارهن يتعاورن لحم الناقة المشوي، ويلقيه بعضهن إلى بعض، وشحمها أيضًا حالة كون لحمها مثل.
[13]
المفردات والمعاني:
الخدر: الهودج، وهو المحمل، له قبة يصنع من أعواد، كانت النساء تركب فيه على ظهور الإبل، وأصل الخدر في اللغة البيت، ويستعار لكل ما يستر من خيمة وغيرها، ومنه قولهم: جارية مخدرة، أي مقصورة في خدرها لا تبرز منه.
عنيزة: اسم عشيقته وهي ابنة عمه، وقيل: هو لقب لها واسمها فاطمة، وقيل: بل اسمها عنيزة وفاطمة غيرها. ويروى البيت (يوم دخلت الخدر يوم عنيزة) فعلى هذه الرواية، فعنيزة اسم مكان.
(لك الويلات): فقيل: هو داء منها عليه في الحقيقة، إذ كانت نخاف أن يعقر بعيرها، وقيل: هو دعاء منها له في معرض الدعاء عليه.
مرجلي: جاعلي أمشي علي رجلي.
الشرح: المعنى يقول: إن يوم دارة جلجل الذي فعل فيه ما فعل، واليوم الذي عقر فيه ناقته للعذارى، واليوم الذي دخل فيه خدر عنيزة، فدعت عليه، أو دعت له، وقالت: إنك تصيري راجلة لعقرك بعيري كان من أفضل الأيام.
[14]
المفردات والمعاني:
الغبيط: ضرب من الرحال، وقيل: بل ضرب من الهوادج.
الباء: في قوله: بنا للتعدية، وقد أمالنا الغبيط جميعا.
عقرت بعيري: أي: أدبرت ظهره، من قولهم: سرج معقر وعقر وعقرة يعقر الظهر. ومنه قولهم: كلب عقور، ولا يقال في ذي الروح إلا عقور. يقال لعقر: عقرت: جرحت، واعتقر وانعقر ظهر الدابة من الرحل.
بعيري: يقع البعير على الذكر والأنثى.
امرأ: هذه الكلمة أصلها المرء، ولما كثر استعمالهم لها حتى أصبحت تستخدم للدلالة على الإنسان.
الشرح: يقول: إن عنيزة كانت تقول لي بعد دخولي الخدر معها، وفي حالة إمالة الهودج، لأنني أنثي عليها، واقبلها فنصير في شق واحد: قد أدبرت ظهر بعيري، فانزل عنه، ودعني وحدي.
[15]
المفردات والمعاني:
الزمام: الخيط الذي يشد في برة البعير، ثم يشد في طرفه المقود، وقد يسمى المقود زماما.
الجنى: هو في الأصل اسم لما يجتنى من ثمر الشجر، قال تعالى: {وجنى الجنتين دان} فقد جعل محبوبته بمنزلة الشجرة التي يجتنى جناها، وجعل ما نال من عناقها وتقبيلها وشمها بمنزلة الثمرة.
المعلل: المكرر، من قولهم: عله يعله إذا كرر سقيه، وعلله للتكثير والتكرير، والمعلل الملهي من قولك: عللت الصبي بشيء، أي ألهيته به، ويروى بكسر اللام وفتحها والمعنى واحد.
وأرخى : إِرْخَاءُ السَّتَائِرِ: إِسْدَالُهَا، إِنْزَالُهَا ، ومنها قول الصحابي علي بن أبي طالب:
الشرح: المعنى يقول: قلت للحبيبة بعد أن أمرتني بالنزول عن بعيرها: سيري وأرخي زمامه على غار به، ولا تبالي أعقر أم سلم؟ ولا تبعديني مما أنال من عناقك وشمك وتقبيلك الذي أكرره، ولا أمل منه، أو الذي يلهمني عما أنابني من الهموم.
أَرخِ الزِّمَامَ ولا تخفْ من عائقٍ …................. فاللُه يُرْدِيهم عَنِ التنكيلِ
[16]
المفردات والمعاني:
مثلك: (مخاطباً عنيزة): يُقصد به المخاطَب، وهنا المقصود عنيزة. خفض فمثلك بإضمار رب، أراد فرب امرأة حبلى.
طرقت: تعني الزيارة أو القدوم ليلاً. ومنها اشتقاق كلمة "طروق" التي تعني القدوم في الليل، ومن ذلك تسمية النجم بـ"الطارق" في قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ} (القرآن، 86:1-3)، لأنه يظهر ليلاً.
مرضع: المرأة التي لها طفل ترضعه. لم تُؤنث الكلمة (أي لم تحمل علامة التأنيث) لأنها تدل على النسبة، أي "ذات إرضاع" أو "ذات رضيع". ومن الأمثلة المشابهة: حائض (المرأة الحائض)، طالق (المرأة المطلقة)، وحامل (المرأة الحامل). في العربية، الأسماء التي تدل على النسبة من هذا النوع غالبًا ما تُجرد من علامة التأنيث، كما في قولهم: "امرأة لابن تامر"، أي ذات لبن أو ذات تمر، وكذلك "رجل لابن تامر"، أي ذو لبن أو ذو تمر. ومنه قوله تعالى: {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ}، حيث نص الخليل على أن المعنى: السماء ذات انفطار به، ولذلك جُردت كلمة "منفطر" من علامة التأنيث. وكذلك قوله تعالى: {قَالَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ}، أي ليست ذات فرض. أما إذا بُني الوصف على الفعل "أنت"، فيقال: أرضعت، فهي مرضعة... إلخ. ومنه قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ}.
ألهيتها: شغلتها وصرفتها.
تمائم: جمع تميمة، وهي المعاذة التي تعلق على جبهة الصبي، وقاية من العين أو السحر.
محول: اسم فاعل من أحول الصبي، إذا تم له حول من عمره، ويروى مكانه (مغيل) وهو الذي تؤتى أمه، وهي ترضعه، أو هو الذي يرضع على حمل، وإنما خص الحبلى والمرضع بالذكر لأنهما أزهد النساء في الرجال، ولا تنس أن كل حامل تمنع الذكر إلا المرأة.
الشرح: يقول الشاعر: يا عنيزة، كثيرًا ما زرت امرأة مثلك حاملاً في الليل، وكثيرًا ما زرت امرأة مثلك مرضعًا ليلاً أيضًا، فألهيتها عن طفلها الصغير الذي يحمل التعاويذ والتمائم المعلقة عليه لحمايته من العين، وقد أكمل عامه الأول. ورغم أن الحامل والمرضع من أكثر النساء زهدًا في الرجال بسبب انشغالهما، فقد تعلقتا بي ومالتا إليّ لوسامتي وجمالي. فكيف لكِ أنتِ أن تفلتي مني؟
[17]
المفردات والمعاني:
بكى: مر ذكره في البيت الأول قفا نبك ،فراجع اليه - .
خلفها: ورائها.
انصرفت: هو في الأصل انقلبت، وأراد مالت وانحرفت، انظر البيت ١٩.
الشق: هو نصف الشيء.
يحول: يروى مكانه لم يحلحل، أي لم يحرك.
الشرح: المعنى يقول: إن المرضع التي يخلو بها إذا بكى صبيها من خلفها انحرفت إليه بنصفها الأعلى، فأرضعته وأرضته، بينما تحته نصفها الأسفل لم تحوله عنه، فقد رصف غاية ميلها غليه، وكلفها به حيث لم يشغلها عن مرامه ما يشغل الأمهات عن كل شيء.
[18]
المفردات والمعاني:
الكثيب: الرمل المجتمع المرتفع، والجمع أكثبة وكثب وكتبان.
تعذرت: تعسرت وتصعبت، والتعذر التشدد والالتواء، وقيل: تعذرت جاءت بالمعاذير من غير عذر.
آلت: حلفت.
لم تحلل: لم تستثن، أي لم تقل: عن شاء الله فترجع إلي.
الشرح: المعنى يقول: إن العشيقة قد تشددت وتصعبت علي في يوم من الأيام على ظهر الكثيب المعروف، وحلفت يمينا لم تستثن فيه أنها تقاطعني وتهجرني، فيحتمل أن يكون صفة حال اتفقت له مع عنيزة، كما يحتمل أنها مع المرضع التي وصفها في البيتين السابقين.
[19]
المفردات والمعاني:
فاطم: مرخم فاطمة، قال ابن الكلبي: هي فاطمة ابنة عبيد بن ثعلبة بن عامر، وهي التي قال لها مرة:
مهلا: رفقا مصدر مهل يمهل في العمل إذا عمله برفق.
الإدلال والتدليل: أي يثق الإنسان بحب غيره إياه فيؤذيه على حسب ثقته به، والاسم الدالة والدال والدلال.
أزمعت: قال الأصمعي: يقال: قد أزمعت على الأمر، وأجمعت عليه، وعزمت عليه سواء، أي جزمته وصممت على فعله.
صرَمِي: قطيعتي وهجري، يقال: صرمت الشيء أصرمه صرما إذا قطعته، قال تعالى: {إذ أقسموا ليصر منها مصبحين}.
الشرح: لا وأبيك ابنة العامري ... لا يدعي القوم أني أفر
وقيل: إن فاطمة هي عنيزة المذكورة في البيت -١٨ - وعنيزة لقب لها. خلاصة البيت: يا فاطمة، دعي شيئًا من هذا الدلال والصدود، فإن كنتِ قد نويتِ هجري وقطيعتي، فكوني رؤوفة بي، وأحسني معاملتي، واجعلي الفراق لطيفًا. قال الله تعالى: {واهجرهم هجراً جميلاً}، وقيل: الهجر الجميل هو الذي يخلو من الإيذاء.
[20]
المفردات والمعاني:
ساءتك: آذتك، إذ الإساءة الإيذاء.
خليقة: قال ابن الأنباري: الخليقة والطبيعة والسجية والسليقة، والسوس والنوس كله واحد، أي هو بمعنى الخلق.
سلي: شدي واستخرجي.
تنسل: بكسر السين وضمها تخرج وتبين عنها، ال تعالى: {ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يسلون} قال خالد بن كلثوم: كان طلاق أهل الجاهلية أن يسل الرجل ثوبه من امرأته، وتسل المرأة ثوبها منه.
الشرح: وقيل: إن الثياب هنا كناية عن القلب، وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالى: {وثيابك فطهر} معناه طهر قلبك، كما أراد امرؤ القيس بالثياب القلوب في قوله:ثياب بني عوف طهارى نقية ... وأوجههم عند المشاهد غران
المعنى يقول: أيتها الحبيبة إن آذاك شيء من أخلاقي ففارقيني كما تريدين وتحبين، فإني لا أريد إلا ما أردت، فأنا طوع لك، فإن أردت فراقي أدته، وإن كان يسبب هلاكي، ويجلب موتي، والمعنى على التفسير الثاني للثياب استخرجي قلبي من قلبك يفارقه إن ساءك خلق من أخلاقي، وكرهت خلة من خلالي، فأنا راض بما تفعلين لا أعارضك بشيء فيه سرورك وارتياحك.
[21]
المفردات والمعاني:
غرك: خدعك وحملك على الاغترار، قال تعالى: {وغركم بالله الغرور} ورجل غر وغرير مجرب للأمور، والغرة الغفلة.
قاتلي: مذللي ومستعبدي، والقتل التذليل والاستبعاد.
القلب: قيل أراد قلبه، ويكون الاستفهام للتقرير، وقيل: أراد قلبها وألف الاستفهام دخلت على هذا القول للتقرير لا للاستفهام والاستخبار، ومنه قول جرير: [الوافر]:
الشرح: ألستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح
المعنى يقول: قد غرك مني أن حبي لك مذللي ومستعبدي، وأن قلب منقاد لأوامرك بحيث تأمرينه لا يعصيك بشي، أو المعنى قد غرك مني ظان حبك مذللي، وأنك تملكين قلبك بحيث تأمرينه لا يعصيك بشيء، فتظنين أني أملك عنان قلب كما ملكت عنان قلبكن حتى يسهل على فراقك كما يسهل عليك فراقي، ومن الناس من حمله على مقتضى الظاهر.
[22]
المفردات والمعاني:
قسمت: قسم الشيء جزأه وفرقه أجزاء.
الفؤاد: القلب.
قتيل: اسم مفعول بمعنى مقتول، يستوي فيه المذكر والمؤنث، وأراد بقتيل التذليل والاستبعاد كما في البيت السابق.
مكبل: مقيد من كبله يكبله كبلا إذا قيده، والكبل القيد، أو أعظم ما يكون من القيود، والجمع كبول وأكبل.
الشرح: والمعني يقول: وقد طمعك في كونك جزأت قلبي جزأين، أو نصفين، فنصف منه مذلل ومستبعد، ونصف منه مقيد في قيود حبك، لا يستطيع أن يلتفت إلى غيرك، ولا يزال ينبض بالشوق إليك، وفي البيت استعارة ظاهرة.
[23]
المفردات والمعاني:
ذرف الدمع: ذريفا وذرفانا وتذرافا إذا سال، ثم يقال: ذرفت [عينه] ، كما يقال: دمعت عينه، والأعشار من قولهم: برمة أعشار إذا كانت قطعا، ولا واحد لها من لفظها.
المقتل: المذلل غاية التذليل، والقتل في الكلام التذليل، ومنه قولهم: قتلت الشراب إذا قللت غرب سورته بالمزاج، ومنه قول الأخطل: [الطويل]:
الشرح: قلت اقتلوها عنكم بمزاجها ... وحب بها مقتولة حين تقتل
تلخيص المعنى على هذا القول: وما دمعت عيناك وما بكيت إلا لتصيدي قلبي بسهمي دمع عينيك وتجرحي قطع قلبي الذي ذللته بعشقك غاية التذليل، أي نكايتهما في قلبي نكاية السهم في المرمى.
[24]
المفردات والمعاني:
رب بيضة خدر: يعني: ورب امرأة لزمت خدرها، ثم شبهها بالبيض.
لا يرام: لا يطلب ولا يقصد، وذلك لعزها وصيانتها، فدون الوصول إليه الأهوال.
الخباء: هو ما كان على عمودين أو ثلاثة، والبيت ما كان علي ستة أعمدة إلى التسعة، والخيمة ما كان على الشجر.
تمتعت: ن التمتع، وهو الانتفاع بالشيء مع التلذذ.
اللهو: اللعب.
غير معجل: غير متعجل، وأراد غير خائف من أحد.
الشرح: المعنى يقول: رب امرأة بيضاء مخدرة مكنونة لا تبرر للشمس، ولا تظهر للناس، ولا يصل إليها أحد لعزها وصيانتها، وصلت إليها، وتمتعت بها غير خائف من أحد، وقد فعلت ذلك مرات.
[25]
المفردات والمعاني:
تجاوزت: قطعت، وقيل: معناه مررت.
الأحراس: جمع حارس، مثل صاحب وأصحاب، وناصر وأنصار، ويجوز أن يكون جمع حرس بمنزلة جبل وأجبال، وحجر وأحجار، ثم الحرس يكون جمع حارس، بمنزلة خادم وخدم.
المعشر: الجماعة، وهو جمع لا واحد له من لفظه، مثل نفر وقوم ورهط.قيل القوم. والجمع المعاشر.
حراصا: جمع حريص، مثل ظراف وكرام.
يسرون: ويروى يشرون بالشين، فمن رواه بالسين احتمل أن يكون معناه (يكتمون) ويحتمل أن يكون معناه (يظهرون) فهو من الأضداد، وقيل في قوله تعالي: {وأسروا الندامة لما رأوا العذاب} إن معناه أظهروا، وقيل: معناه كتموها ممن أمروه بالكفر، وأيضا قوله تعالى {وأسروا النجوى الذين ظلموا} أي يحتمل أظهروا وأخفوا.
الشرح: المعني يقول: تجاوزت في ذهابي إلى المحبوبة، وزياتي إياها أهوالا كثيرة، وقوما يحرسونها، وقوما حراصا على قتلى لو قدروا عليه في خفية أو في جهر، ولكنهم لا يجترئون على قتلي في حال من الحالين لشرفي ونباهتي وموضوعي من قومي، لأنه كان ملكا، والملوك لا يجترئ أحد على قتلهم.
[26]
المفردات والمعاني:
الثريا: مجموعة نجوم في عنق الثور، ويشبهون بها الجموع الخفيفة في حسن النظام.
التعرض: الاستقبال، والتعرض إبداء العرض، وهو الناحية، والتعرض الأخذ في الذهاب عرضا.
الأثناء: النواحي، والأثناء الأوساط.
الوشاح: خرز يعمل من كل لون.
المفصل: الذي فصل بين كل خرزتين منه بلؤلؤة.
الشرح: المعنى يقول: تجاوزت إلى المحبوبة في وقت إبداء الثريا عرضها كإبداء الوشاح الذي فصل بين كل خرزتين منه بلؤلؤة، فقد شبه اجتماع كواكب الثريا، ودنو بعضها من بعض بالوشاح المنظم بالودع المفصل بين كل خرزتين منه بلؤلؤة.
[27]
المفردات والمعاني:
نضت: بتشديد الضاد، وتخفيفها خلعت وألقت، والتخفيف أولى، نضا الثياب ينضوها نضوا إذا خلعها.
الستر: بكسر السين ما يستر به، فهو اسم آلة، والجمع ستور وأستار.
اللبسة: حالة اللابس وهيئة لبسه الثياب بمنزلة الجلسة.
المتفضل: اللابس ثوبا واحدا إذا أراد الخفة في العمل والفضلة والفضل اسمان لذلك.
الشرح: يقول: أتيتها وقد خلعت ثيابها عند النوم غير ثوب واحد تنام فيه وقد وقفت عند الستر مترقبة ومنتظرة، وإنما خلعت الثياب لتري أهلها أنها تريد النوم.
[28]
المفردات والمعاني:
اليمين: الحلف.
الحيلة: هي الحذق والمهارة في تدبير الأمور، وتقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ،
الغواية والغي: الضلالة.
تنجلي: من الانجلاء: الانكشاف.
الشرح: اللمعنى يقول: فقالت لي الحبيبة لما رأتني: أقسم بالله لا أقدر أن أحتال في دفعك عني، أو مالك عذر في زيارتك لي في هذه الساعة، وإني أراك غير كاف عن جهلك وغيك، وضلالك، وانظر معنى البيت الآتي.
[29]
المفردات والمعاني:
خرجت بها: أفادت الباء تعدي الفعل.
وراءنا: خلفنا، وقد يأتي وراء بمعنى أمام كما في قوله تعالي: {ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون} أي: ومن أمامهم.
أثرينا: تثنية أثر وهو ما بقي من رسم الشيء، وضربة السيف ونحوه، الأثر والإثر واحد.
الذيل: آخر الشيء، وذيل الثوب ما جر منه إذا أسبل.
المرط: بكسر الميم كساء من خز أو صوف، وقد تسمى الملاءة مرطا أيضا، والجمع المروط.
المرحل: المنقش بنقوش تشبه رحال الإبل.
الشرح: يقول: فأخرجتها من خدرها وهي تمشي وتجر مرطها على أثرنا لتعفي به آثار أقدامنا، والمرط كان موشي بأمثال الرحال.
[30]
المفردات والمعاني:
أجزنا: قطعنا مثل جزنا.
الساحة: فناء الدار.
الحي: القبيلة.
الانتحاء والتنحي والنحو: الاعتماد على الشيء، ذكره ابن الاعرابي.
البطن: مكان مطمئن حوله أماكن مرتفعة والجمع أبطن وبطون وبطنان.
الخبت: أرض مطمئنة ، منخفض من الأرض غامض، أي مجهول.
الحقف: رمل مشرف معوج، والجمع أحقاف وحقاف، وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ، ولم يبلغ أن يكون جبلا.
العقنقل: الرمل المنعقد المتلبد.
الشرح: المعني يقول: فحينما تركنا حلة القوم. وخرجنا من بين البيوت، وصرنا إلي أرض منخفضة يحيط بها تلال من رمل منعقد داخل بعضه في بعض، وجواب لما في البيت التالي.
[31]
المفردات والمعاني:
هصرت: جذبت وثنيت.
فودى رأسها: جانبي رأسها، وأراد ذؤابيتها.
تمايلت: أي: مالت. ويروى بغصني دومة والدوم: شجر المقل١، واحدتها دومة، شبهها بشجرة الدوم ، تمايلت.
النول والإنالة والتنويل: الإعطاء، ومنه قيل للعطية نوال.
الكشح: هو ما بين منقطع الأضلاع إلى الورك.
هضيم الكشح: ضامر الكشح، والجمع كشوح وأصل الهضم الكسر، والفعل هضم يهضم.
ريّا: تأنيث الريان. أي ملأى، أي غليظة ضخمة، والريا الرائحة كما رأيت في البيت رقم -١١.
المخلخل: موضع الخلخال من الساق، فقد عبر عن كثرة لحم الساقين وامتلائها بالري، والعرب تستحسن من المرأة دقة الخصر وعبالة الساقين.
الشرح: المعنى يقول: لما خرجنا من الحلة، وأمنا الرقباء جذبت ذؤابتيها إلي فطاوعتني فيما أرات منها، ومالت على ملبية طلبتي منها في حال ضمور كشحها، وامتلأ ساقيها باللحم.
[32]
المفردات والمعاني:
(يقول: محمد علي طه الدرة في كتاب فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال): “هذا البيت ولاحقه لم يذكرهما أحد من شراح المعلقة، لقد وجدتهما في الديوان بعد البيت السابق.”
التفتت: معناه معروف، وهو أحد الأفعال التي يتغير معناها بتغير الجار ،
نحوي: النحو يجئ في اللغة لمعان خمسة: الجهة، نحو توجهت نحو البيت، أي جهة البيت، وهو المراد هنا، والقصد، والمقدار، القسم، والمثل.
تضوع: فاح وانتشر المسك يذكر ويؤنث، وكذلك العنبر.
نسيم الصبا: أردا تنسمها، وهو هبوبها لينة هادئة.
الشرح: المعنى يقول: إن المحبوبة إذا التفتت نحوي وجهتي، فاحت رائحتها مثل نسيم الصبا إذا حملت رائحة القرنفل الطيبة.
[33]
المفردات والمعاني:
المهفهفة: اللطيفة الخصر الضامرة البطن.
المفاضة: المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم. جمع تريبة، وهو موضع القلادة من الصدر.
صقولة: مجلوة، والسقل والصقل إزالة الصدأ من الحديد والنحاس وغيرهما.
السجنجل: المرآه لغة رومية عربتها العرب. ويروى مصقولة بالسجنجل، وفسر بماء الذهب والفضة.
الشرح: المعنى يقول: إن المحبوبة، دقيقة الخصر، ضامرة البطن، ليست عظيمة البطن، ولا مسترخية وصدرها براق اللون، متلألئ الصفا كأنه المرأة، أو كأنه ماء الذهب والفضة.
[34]
المفردات والمعاني:
ما لم يسبقه مثله: المقاناة: الخلط يقال: قانيت بين الشيئين إذا خلطت أحدهما بالآخر، والمقاناة في البيت مصوغة للمفعول دون المصدر.
غذاها: الضمير يعود إلى المرأة الموصوفة بهذا الكلام، والغذاء ما يغتذي به من الطعام والشراب.
النمير: الماء النامي في الجسد، لأن النمير ما كان شارب طويل الري، والذي يعطش صاحبه سريعًا ليس بنمير.
غير محلل: يروي بفتح اللام، وفسر بمكدر أي لم يكثر حلول الناس عليه، فيكدره ذلك ويروى بكسرها.
الشرح: تلخيص المعنى على هذا القول: إنها بيضاء تشوب بياضها صفرة وقد غذاها ماء نمير عذب صافٍ، والبياض الذي شابته صفرة أحسن ألوان النساء عند العرب.
[35]
المفردات والمعاني:
الصد والصدود: الإعراض والصد أيضًا الصرف والدفع، والفعل منه صدَّ يصُدُّ، والإصداد الصرف أيضًا. وللإعراض قال تعالى: {وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله، وإلي الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا}.
تبدي: تظهر.
أسيل: الأسالة، امتداد وطول في الخد وقد أسل أسالة فهو أسيل.
تتقي: الاتقاء الحجز بين الشيئين، قال: اتقيته بترس، أي جعلت الترس بيني وبينه.
ناظرة: عين ناظرة.
الوحش: جمع وحشي.
جرة: اسم موضع، وأراد بوحش وجرة ظباءها.
مطفل: هي التي لها طفل ترضعه.
الشرح: المعنى: أنها تعرض عنا فتظهر في إعراضها خدًّا أسيلا وتسقبلنا بعين مثل عيون ظباء وجرة أو مهاها واللواتي لها أطفال، وخصهن لنظرهن إلى أولادهن بالعطف والشفقة وهي أحسن عيونًا في تلك الحال منهن في سائر الأحوال.
[36]
المفردات والمعاني:
الجيد: العنق، وجمعه أجياد وجيود.
الرئم: الظبي الأبيض الخالص البياض، والجمع آرام.
الفاحش: هو ما جاوز القدر المحمود من كل شيء، وأراد هنا ليس بكريه المنظر.
نصّته: النص: الرفع، ومنه سمي ما تُجلى عليه العروس مِنَصَّة.
معطل: أراد لا حلي فيه.
الشرح: المعنى يقول: إن المحبوبة تبدي أيضًا عن عنق كعنق الظبي الأبيض الخالص البياض، ليس بكريه منظره، إذا رفعته وهو غير خال من الحلي كعنق الظبية، بل يوجد فيه حلي.
[37]
المفردات والمعاني:
فرع: هو الشعر التام، يقال: رجل أفرع وامرأة فرعاء إذا كان شعرهما تامًا.
المتن: الظهر، وهو قوام البدن ينبني عليه سائرأعضائه، ويستعار لأشياء كثيرة كما هو معروف.
أسود فاحم: وأسود حالك، إذا كان شديدًا سواد.
الفاحم: الشديد السواد، مشتق من الفحم.
أثيث: كثير أصل النبات.
القنو: العذق، وهو الشمراخ، وهو النخلة كالعنقود من العنب، ومثله القنو والقنا، ويجمع القنو على قنيان وقنيان، وقنوان وقنوان، قال تعالي: {ومن النخل من طلعها قنوان دانية}.
النخلة المتعثكلة: التي خرجت عثاكيلها أي: قنوانها.
المتعثكل : هو الذي دخل بعضه في بعض لكثرته، وقيل: هو المتراكب بعضه فوق بعض.
الشرح: المعني يقول: إن المحبوبة تبدي أيضًا عن شعر طويل تام، يزين ظهرها إذا أرسلته عليه، وهذا الشعر أسود شديد السواد، كما هو كثيف شديد الكثافة، كأنه عذق نخلة متراكب بعضه فوق بعض.
[38]
المفردات والمعاني:
الغدائر: الذوائب، جمع الغديرة: وهي الخصلة من الشعر، الشعر المتدلي من الضفيرة في مقدمة الرأس، أو الشعر المجدول.
مستشزرات: مرفوعات، وأصل الشزر الفتل على غير جهة، فأراد أنها مفتولة علي غير الجهة لكثرتها.
إلى العلا: إلى ما فوقها.
تضل: تغيب وهو في الأصل يضيع ويهلك، والضلال ضد الرشاد.
العقاص: جمع عقيصة، والجمع عقص وعقائص، وهي خصلة المجموعة من الشعر مثل الكبة.
مثني: متجعد، أي مفتول بعضه على بعض.
مرسل: مسرح غير مفتول.
الشرح: المعنى يقول: إن ذوائب العشقية مرفوعات، أو مرتفعات إلى فوق، أي أنها مشدودة على الرأس بخيوط، تغيب عقاصها في شعر بعضه متجعد، وهذا يستشهد بقوله (مستشزرات) على أن في هذا الكلمة تنافر الحروف ما جعلها ثقيلة على اللسان، وهو وصف يخرج الكلام من الفصاحة، إذ فصاحة الكلام مشروطة بسلامة كلماته من تنافر الحروف.
[39]
المفردات والمعاني:
كشح الكشح: منقطع الأضلاع، والجمع كشوح وأصل الهضم الكسر، قد مرذكره في بيان البيت "هصرت بفودي رأسها فتمايلت ... على هضيم الكشح ريا المخلخل".
لطيف: ضامر حسن.
الجديل: أراد به زمام الناقة الذي يتخذ من السيور، فيكون حسنًا لينًا يتثنى، وهو مأخوذ من الجدل، وهو شدة الخلق. قيل "خطام" ما يجعل في أنف البعير ليقتاد به.
خصر: دقيق الخصر، والخصر وسط الإنسان فوق الورك، فهو بمعنى الكشح.
الأنبوب: ما بين العقدتين من القصب وغيره، والجمع الأنابيب.
السَّقِيِّ ههنا: بمعنى المسقي كالجريح بمعنى المجروح، والْجَنِي بمعنى المجني.
السقي: النخل الذي يسقى، وهو بمعنى المسقي كالجريح بمعنى المجروح.
المذلل: أي المدلل له الماء، أي إنه يسقى كثيرًا.
الشرح: المعنى يقول: وإن العشيقة لتبدي عن كشح ضامر يشبه في دقته وليونته خطام ناقة متخذًا من الأدم، وتبدي عن ساق يشبه في صفاء لونه أنابيب بردي، قد كثر سقيه.
[40]
المفردات والمعاني:
يضحي: يبقى إلى الضحى، مصادفة الضحى.
فتيت المسك: ما تفتت منه، أي تحات عن جلدها في فراشها.
نؤوم: صيغة مبالغة يستوي فيها المذكر والمؤنث، يقال: رجل نؤوم، وامرأة نؤوم، مثل ظلوم.
لم تنطق عن تفضل: أي لم تنتطق لتعمل.
الشرح: المعنى يقول: إن العشيقة تنتبه من النوم في ضحوة النهار، وفتيت المسك فوق فراشها الذي نامت عليه، أو المعنى: إن فتيت المسك يبقى إلى الضحى فوق فراشها الذي نامت عليه، وهي كثيرة النوم في وقت الضحى لأنها تكفى أمورها، فلا تباشر عملًا بنفسها، ولذا فإنها لا تشد وسطها بنطاق لأجل العمل، فهي مخدومة منعمة تخدم، ولا تخدم.
[41]
المفردات والمعاني:
تعطو: تتناول، والعطو التناول، والإعطاء المناولة.
رخص: لين ناعم، وهو صفة لموصوف محذوف، أي ببنان رخص، والبنان الأصابع.
الشثن: الغليظ الكز.
أساريع: جمع أسروع ويسروع، وهو دود يكون في البقل، والأماكن الندية، تشبه أنامل النساء الحسان به.
ظبي: اسم موضع.
المساويك: جمع مسواك. شجرة تدق أغصانها في استواء، تشبه الأصابع بها في الدقة والاستواء.
الشرح: المعنى يقول: إن العشيقة تتناول الأشياء بأصابع رشيقة لينة ناعمة، ليست بخشنة، ولا بغليظة، فهي تشبه النوع المذكور من الدود، أو الضرب من المساويك المتخذة من أغصان الشجر المذكور، وهو شجر الإسحل.
[42]
المفردات والمعاني:
تضيء: من الإضاءة، وهي الإشراق، ففعله يكون متعديًا كما هنا، وكما في قوله تعالى: {فلما أضاءت ما حوله} ويكون لازمًا كما في قوله تعالى: {كلما أضاء لهم مشوا في}.
المنارة: محل مرتفع يوضع فيه ضوء في الليل.
الممسى: بمعنى: الإمساء والوقت جميعًا؛ وهو ضد الإصباح،ومنه قول أمية:
الراهب: يجمع على الرهبان، أراد به المتعبد من النصارى.
المتبتل: المنقطع إلى الله بنيته وعمله، والبتل: القطع، ومنه قيل: مريم البتول لانقطاعها عن الرجال.
الشرح: الحمد لله ممسانا ومصبحنا ... بالخير صبّحنا ربي ومسانا
يقول: تضيء العشيقة بنور وجهها ظلام الليل فكأنها مصباح راهب منقطع عن الناس، وخص مصباح الراهب؛ لأنه يوقده ليهتدي به عند الضلال فهو يضيئه أشد الإضاءة، يريد أن نور وجهها يغلب ظلام الليل كما أن نور مصباح الراهب يغلبه.
[43]
المفردات والمعاني:
يرنو: يديم النظر.
الحليم: العاقل، والحلم بكسر فسكون الأناة والروية والعقل، والحليم في صفات الله تعالى معناه الصبور.
صبابة: هي رقة الشوق.
اسبكرت: امتدت، الاسبكرار: الطول والامتداد، والمراد تمام شبابها.
الدرع: هو قميص المرأة الكبيرة.
مجول: درع خفيف تلبسه الصغيرة.
الشرح: المعنى يقول: إلى مثل العشيقة ينظر العاقل، ويديم نظره شغفًا بها، إذ طال قدها وامتدت قامتها، وصارت متوسطة في السن بين من تلبس الدرع، وبين من تلبس المجول.
[44]
المفردات والمعاني:
تسلت: من السلو، وهو زوال الحب من القلب، أو زوال حزنه.
عمايات: جمع عماية، وهي الجهالة.
الصبا: بكسر الصاد اللعب واللهو كفعل الصبيان.
الهوى: يقصر ويمد، والمراد بالأول الحب والعشق والغرام.
بمنسل: صيغة اسم فاعل من السلو أيضًا.
الشرح: زعم أكثر الأئمة أن في البيت قلبًا تقديره: تسلت الرجالات عن عمايات الصبا أي خرجوا من ظلماته وليس فؤادي بخارج من هواها. المعنى يقول: إن عشق العشاق قد بطل وزال، وأما عشقه إياها فهو باق ثابت لا يزول ولا يبطل.
[45]
المفردات والمعاني:
الخصم: المخاصم: من الخصومة والمخاصمة، والخصم يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، قال تعالى: {وهل أتاك نبأ الخصم، إذ تسوروا المحراب؟ }.
ألوى: شديد الخصومة كأنه يلوي خصمه عن دعواه.
نصيح: فهو مبالغة ناصح من النصح.
على: بمعنى في.
التعذال: العذل، وهو التأنيب واللوم والتوبيخ والتقريع ألفاظ مترادفة والفعل عذل يعذله.
مؤتلي: مقصر، يقال: ما ألوت وما أليت: أي ما قصرت، قال تعالى: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين).
الشرح: المعنى يقول: كم شخص خاصمني فيك ولا مني لومًا شديدًا على حبي لك غير مقصر في سداد النصيحة لي، فلم أصغ لكلامه، ولم أكف عن حبك لأن حبك قد استولى على قلبي وملك مشاعري.
[46]
المفردات والمعاني:
وليل كموج البحر: فقد شبه ظلام الليل بموج البحر في شدة هوله، وعظيم ما يناله من المخافة فيه.
السدول: الستور، الواحد منها سدل.
الإرخاء: إرسال الستر وغيره.
الهموم: جمع الهم. بمعنى الحزن وبمعنى الهمة.
الباء: في قوله: بأنواع الهموم بمعنى مع.
ليبتلي: أي ليبتلني، أي ليختبر ما عندي من الصبر أو الجزع قال تعالى {{فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه} أي اختبره بالنعمة، أو بالنقمة.
واو ليل : واو رب.
الشرح: المعنى يقول: كم شخص خاصمني فيك ولا مني لومًا شديدًا على حبي لك غير مقصر في سداد النصيحة لي، فلم أصغ لكلامه، ولم أكف عن حبك لأن حبك قد استولى على قلبي وملك مشاعري.
[47]
المفردات والمعاني:
تمطى: تمدد، أو امتد وطال، وجاء يتمطى في قوله تعالى: {ثم ذهب إلى أهله يتمطى} بمعني يتبختر: وأصله يتمطط، أي يتمدد، ويجوز أن يكون التمطي مأخوذًا من المطا، وهو الظهر، فيكون التمطي مد الظهر.
الصلب: هو في الأصل الشديد، وهو أيضًا عظم في الظهر ذو فقار يمتد من الكاهل إلى أسفل الظهر، وأراد به وسط الليل على سبيل المجاز.
أردف: اتبع، والإرداف الإتباع، وأردفه أركبه خلفه.
الأعجاز: جمع عجز، وهو المؤخر من كل شيء، ومعنى (أردف أعجازًا) أنه قد تراكبت مآخيره وتتابعت.
ناء: نهض بجهد، قال تعالى: {وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة}، وقيل ناء\مقلوب نأى بمعنى بعد.
الكلكل: الصدر والجمع كلاكل.
الباء: في قوله ناء بكلكل.
الشرح: تلخيص المعنى: قلت لليل لَمّا أفرط طوله وناءت أوائله وازدادت أواخره تطاولًا، وطول الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد والسهر المتولد منها؛ لأن المغموم يستطيل ليله، والمسرور يستقصر ليله.
[48]
المفردات والمعاني:
انجلي: انكشف.
الأمثل: الأفضل، والمثلى الفضلى، والأماثل الأفاضل.
الشرح: المعني يقول: قلت لليل لما تطاول علي، ولم ينقشع ظلامه الحالك عني: ألا أيها الليل الطويل انكشف، أي اذهب ليأتي الصباح بنوره الوضاح، ثم استدرك، وقال: ليس الصباح بأفضل منك عندي، لأني أقاسي الهموم نهارًا كما أقاسيها ليلا، وخطابه ما لا يعقل يدل على فرط الوله، وشدة التحير.
[49]
المفردات والمعاني:
يا لك من ليل: هو تعجب من طول الليل.
الأمراس: جمع مرس: وهو الحبل، وقد يكون المرس جمع مَرَسة وهو الحبل أيضًا، فتكون الأمراس حينئذ جمع الجمع.
مغار الفتل: محكم الفتل، وأراد به حبلا مفتولا فتلا شديدا.
شدت: ربطت.
يذبل: اسم جبل بعينه.
الشرح: لمعني يقول مخاطبًا الليل: فأعجب لك من ليل طويل كأن نجومه قد ربطت بجبل يذبل بكل حبل محكم الفتل، فهي ثابتة لا يتحرك، وذلك أنه ستطال الليل كما رأيت في الأبيات السابقة.
[50]
المفردات والمعاني:
الثريا: مجموعة نجوم في عنق الثور، ويشبهون بها الجموع الخفيفة في حسن النظام، وتناسب الأفراد، وتلازم المجتمعين حتى كأنهم لا يتفارقون.
مصامها: في مكانها وموضعها.
الأمراس: جمع مرس، وهو الحبل المفتول، والكتان نبات له زهر أورق تنسج منه الثياب.
صم جندل: حجارة صلبة، والجمع جنادل، والواحدة جندلة، والجندل الصخر العظيم.
الشرح: المعني يقول: بعد أن ذكر النجوم في البيت السابق وحالها بالنسبة إليه كأن الثريا قد ربطت أيضًا بحبال متبنة مشدودة إلى حجارة صلدة، فهي لا تتحرك بنظره وذلك لاستطالته الليل كما رأيت في الأبيات السابقة.
[51]
المفردات والمعاني:
أغتدي وأغدو: معناها واحد، وهو الذهاب في الغدو.
الطير: جمع طائر، قال قطرَب وأبو عبيدة: إن الطير يقع على الواحد والجمع.
الوكنات: بضم الواو، وضم الكاف وفتحها وسكونها، جمع وكنه بتثليث الواو وضم الكاف وسكونها، وهي عش الطير ووكره، وقد تقلب واو وكنة وهمزة، فيقال أكنة.
منجرد: قصير الشعر، وذلك جيد في الخيل، إذ طول الشعر هجنة عند العرب.
قيد: ممسك.
لأوابد: واحده آبد وآبدة، وهي الوحوش الشاردة.
هيكل: مرتفع ضخم، والهيكل البناء المرتفع، والهيكل التمثال أيضا.
الشرح: اللمعني يقول: كثيرا ما اذهب مبكرا وقت كون الطير في أعشاشها، راكبا على فرس قصير شعره، سريع ركضه، لا يفلت منه صيد، بل يمسك نوافر الوحوش وشواردها، وهو فرس مرتفع، عظيم الجثة.
[52]
المفردات والمعاني:
مكرّ: كثير العطف- أي العودة مرة بعد أخرى.
مِفرّ: كثير الفِرار (بقصد الرجوع للمبارزة أقوى). يراد بهما الكَرُّ وَالفَرُّ فِي القِتَالِ: الهُجوم وَالتَّرَاجُع ليهجم الفارس ثانية بصورة أشد.
مدبر: حسن الإدبار.
مكر، مفر، مقبل، مدبر: هذه الصفات أربع للفرس المذكور في البيت السابق. قول البغدادي: "مِكر ومِفرّ صيغتا مبالغة (مثل مِصْقَع، مِسعر، مِقوَل).
معا: أي مجتمع فيه هذه الصفات.
الجلمود: الحجر العظيم الصلب.
الصخر: الحجر، واحده صخرة.
حطه: ألقاه من أعلى إلى أسفل.
السيل: الماء الجاري بقوة شديدة.
من عل: من فوق، قيل في من عل ومن علي: بياء ساكنة، ومن عال، مثل قاض، ومن معال مثل معاد.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس المذكور في البيت السابق معتاد للحرب، صالح لجميع أحوالها من الطلب والهرب، والكر والفر، فيكر إذا أريد منه الكر، يفر إذا أريد منه الفرار، ويقبل إذا أريد منه الإقبال، ويدبر إذا أريد منه الإدبار، فهذه الصفات مجتمعة في قوته وقدرته. لا في فعله في حالة واحدة، لما بينها من التضاد، ثم شبهه في سرعة مره، وصلابة خلقه بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان إلى حضيض.
[53]
المفردات والمعاني:
الكُميت من الخيل: ما لونه بين الأحمر والأسود، والفرس الكميت من أصلب الخيل جلودا وحوافر، وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث.
كميت هنا: صفة أخرى للفرس الموصوف في بيت سابق.
يَزِلُّ: ولا يكاد يثبت.
اللبد: بكسر فسكون هو ما يتلبد من شعر أو صوف، وأراد به هنا ما يوضع على ظهر الفرس من سرج وجل وغير ذلك.
حال متنه: ويروى حاذ متنه، وهما بمعني وسط الظهر.
الصفراء: الحجر الصلب الأملس، ومله الصفا والصفوان.
المتنزل: الذي ينزل في مهلة، فكأنه يتكلف النزول، قيل: أراد به المطر النازل، وقيل: أراد الإنسان النازل، وقيل: أراد الطير.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس المذكور في بيت سابق أشهب، أي لونه بين الأسود والأحمر، وهو لاكتناز لحمه وانملاس ظهره، يزل لبده عن ظهره كما أن الحجر الصلد الأملس، يزل الإنسان أو المطر عنه، إذا نزل عليه.
[54]
المفردات والمعاني:
مسح: بكسر الميم وفتح السين العداء السريع الركض الذي أنه يصب الجري صبا.
السابحات: الخيل التي تجري، وكأنها تسبح لسهولة سيرها ولينه، وفي القرآن الكريم {والسابحات سبحا} لسابح من الخيل: الذي يمد يديه في عدوه، شبه بالسابح في الماء.
الوني: الفتور والإعياء، يقال: ونى الرجل يني، إذا فتر وضعف، وفي القرآن الكريم: {ولا تنيا في ذكري}.
أثرن الغبار: هيجنه، وفي القرآن الكريم: {فأثرن به نقعا} والنقع الغبار.
الكديد: الأرض الصلبة.
المركل: من الركل، وهو الدفع بالرجل، وأراد به هنا الذي أكثرت الخيل من ركله بحوافرها، والفعل منه ركل يركل ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "فركلني جبريل". والتركيل التكرير والتشديد.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس الموصوف بالأبيات السابقة يشتد في جريه، إذا تعبت الخيل، وكلت عن الركض حينما تثير الغبار في الأرض الصلبة بحوافرها جيئة وذهوبا.
[55]
المفردات والمعاني:
الذبل: الضمور والضعف كما يروى على الضمر، وعلى العقب أيضًا، والعقب الجري بعد الجري، وقال قوم: أي إذا حركته بعقبك جاش وكفاك ذلك من السوط.
جياش: هو الذي إذا حركته بعقبك يزيد في جريه، ولم ينقطع.
اهتزامه: صوته الشديد.
جاش: بمعني غلي وهاج واضطرب، ومنه جاشت القدر تجيش جيشا وجيشانا إذا غلت.
حمية: حرارته.
المرجل: القدر من نحاس، أو حديد أو نحاس أو شبهه، والجمع المراجل.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس المذكور في الأبيات السابقة تزيد حرارة نشاطه على ذبول خلقه وضمور بطنه، كلما حركته عدا عدوا لا ينقطع، ثم شبه تكسر صهيله في صدره بغليان القدر.
[56]
المفردات والمعاني:
الْخِفّ: الخفيف.
الصهوة: مقعد الفارس من ظهر الفرس، والجمع الصهوات، والصهوة: موضع اللبد، وصهوة كل شيء: أعلاه.
ويلوى بأثواب العنيف: أي يرمى بثيابه يذهبها ويبعدها.
الغلام: أراد به راكب الفرس، وهو لا يكون إلا رجلا.
ويلوي : قيل فيه يلوي: يذهب ويميل، والعنيف: الذي ليس برفيق، والمثقل: الثقيل.
الشرح: المعنى يقول: إن الفرس إذا ركبه العنيف لم يتمالك أن يصلح ثيابه، وإذا ركبه الغلام الخِف زل عنه ولم يُطقه لسرعته ونشاطه، وإنما يصلح له من يداريه.
[57]
المفردات والمعاني:
درير: كثير الجري سريعة، فهو اسم فاعل من در يدر فهو دار، مثل قدير وقادر، وعليم وعالم.
الخذروف: حصاة مثقوبة يلعب بها الصبيان يجعلون بها خيطا يمرونها بين أيديهم بالخيط، فيسمع لها صوت خرخر.
الوليد: الصبي الصغير.
أمره: أداره بالخيط، أو أحكم فتله.
بخيط موصل: معناه قد لعب به حتى خف ويلي وملس، فتقطع خيطه فوصل، فهو أسرع لدورانه.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس المذكور ي بيت سابق كثير الجري سريعة، كسرعة الخذروف الذي أحكم فتل خيطه الموصل الذي يلعب به الصبيان.
[58]
المفردات والمعاني:
له: للفرس.
أيطل: ويروى أطل، وهما الخاصرة والكشح، وهو ما بين آخر الضلوع إلى الورك، فالأربعة بمعني واحد.
ظبي: هو الغزال.
النعام: اسم جنس، واحده نعامة، مل حمامة وجراد وجرادة.
والإرخاء: جرى ليس بالشديد، وفرس مرخاء، وهي مراخي الخيل.
السرحان: الذئب.
التقريب: وضع الرجلين موضع اليدين في العدو.
تتفل: هو ولد الثعلب، وهو أحسن الدواب تقريباّ، ويقال للفرس: هو يعود الثعلبية، إذا كان جيد التقريب.
الشرح: المعني يقول: إن للفرس المذكور في بيت سابق خاصرتين، كخاصرتي الظبي، وساقين كساقي النعامة، وسيراّ كسير الذئب، وعدواّ كعدو ولد الثعلب، فقد جمع أربع تشبيهات في هذا البيت.
[59]
المفردات والمعاني:
المتنان: تثنية متن، وهما الناحيتان من يمين الفقار وشماله.
انْتَحَى: إعتمد عليه.
المداك: الحجر الذي يسحق به الطيب وغيره، والذي يسحق عليه أيضًا مداك، والدَّوك: السحق، الفعل منه داك يدوك دوكًا.
الصَلاية: الحجر الأملس الذي يسحق عليه شيء. وإنما قصد إلى مداك العروس دون غيره لأنه قريب العهد بالطيب، وصلاءة الحنظل؛ لأن حب الحنظل يخرج دهنه فيبرق على الصلاءة.
الشرح: المعني يقول: إن ظهر الفرس المذكور شبيه بالحجر الذي تسحق العروس به، أو عليه الطيب، أو هو شبيه بالحجر الذي يكسر عليه الحنظل، ويستخرج حبه، وخص مداك العروس بالذكر لقرب عهده بالطيب، وذكر صلاية الحنظل لأن دهن الحنظل يخرج بها، فتراه ذا بريق ولمعان.
[60]
المفردات والمعاني:
يُفسّر: بأن الفرس ظلّ طوال الليل مُجهزاً للقتال، لم يُنزع عنه سرجه (ما يُوضع على ظهر الفرس) ولجامه (ما يوضع في فمه من لجام).
بات بعيني: أي بحيث أراه.
غير مرسل: أي غير مرسل إلى المرعي، وإنما يعلف لمزيد العناية به، وبات ليس المراد ليس منه النوم، بل المبيت.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس المذكور في الأبيات السابقة قد بات متهيئا ليرسل في وجه الصبح إلى الحرب والنزال عليه سرجه ولجامه لم ينزعا عنه، قائما بين يدي بحيث أراه غير مرسل إلى المرعي.
[61]
المفردات والمعاني:
عن: عرض وظهر.
السرب: القطيع من النساء، أو الظباء، أو القطا، أو البقر، أو الخيل، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وجمعه أسراب، مثل قوم وأقوام.
النعاج: اسم لإناث الضأن وبقر الوحش وشاء الجبل، واحده نجعة، وبها يكني عن المرأة، وبها فسر قاله تعالى: {إن هذا أخي له تسع وتسعون نجعة، ولي نجعة واحدة}.
عذاري: جمع عذراء، ويراد بها الشابة الفتية البكر، وتجمع العذراء أيضًا على عذاري.
دوار: بفتح الدال وتخفيف الواو حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله تشبيهاّ بالطائفين حول الكعبة، إذا بعدوا عن الكعبة المعظمة.
الملاء: جمع ملاءة، وهي الملحقة تلبسها المرأة، ولا تسمي ملاءة إلا إذا كانت ذات لفقين.
مذيل: طويل الذيل.
الشرح: المعني يقول: لقد عرض لنا قطيع من بقر الوحش كان إناثه نساء عذارى يطفن حول حجر منصوب يطاف حوله في ملاء طويل الذيل، ولا تنس تشبيهه بقر الوحش في بياضها بالعذارى لأنهن مصونات في الخدور، لا يغير ألوانهن حر الشمس وغيره، وتشبيهه طول أذيالها وسبوغ شعرها بالملاء الطويل الذيل، وتشبيهه حسن مشيها بحسن تبختر العذاري في مشيهن.
[62]
المفردات والمعاني:
ادبرن: انصرن متفرقات، والضمير يعود إلى النعاج.
الجزع: بفتح الجيم الخرز اليماني، وبكسرها ما أنعطف من الوادي، وكلاهما بسكون الزاي، وهو بفتح الجيم والزاي ضد الصبر.
مفصل: جعل بينه ما يفصله، واختلف في هذا الفصل.
الجيد: العنق، والجمع أجياد.
معم: كريم الأعمام.
مخول: كريم الأخوال.
العشيرة: هي أقارب الرجل الأقربون في القبيلة وأولاد عمه.
الشرح: المعني يقول: انصرفت النعاج متفرقات كالخرز اليماني الذي فصل بينه بغيره من الخرز الذي يخالفه في اللون، وهذا الخرز المشبه به موجود في عنق صبي كريم أعمامه وأخوال، ووجود الخرز في العنق هذا الصبي يزيده حسنا وجمالا بالإضافة إلى شرف النسب وكريم المحتد.
[63]
المفردات والمعاني:
الهاديات: جمع هادية، وهي المتقدمة من بقر الوحش وغيره من الصيد، والهوادي من الإبل والخيل والحمر، ومن كل شيء أوله.
دون: من الدنو، وهو القرب، ومثله أدني، ومنه تدوين الكتب لأنه إدناء، أي تقريب البعض من البعض، ثم استعير للرتب.
جواحرها: أي المختلفات منها جمع جاحر. وهو المختلف الذي لم يلحق، ولا تنس أن الجحر مكان تحتفره السباع والهوام لأنفسها.
صرة: جماعة، والصرة أيضا الصيحة والضجة، وبها فسر تعالي: {فأقبلت امرأته في صرة، فصكت وجهها، وقالت: عجوز عقيم}.
لم تزيل: لم تفرق، أصله لم تنزيل.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس المذكور في بيت سابق سريع الجري ألحقنا بأوائل الوحش وسوابقه، وترك المقصرات في الركض وراءه ثقة بشدة جريه، فهو يدرك أوائلها، المقصرات منها لا تزال مجتمعة لم تتفرق بعد.
[64]
المفردات والمعاني:
عادي: والى بين اثنين، فهو يريد تابع الجري حتى جمع بين الثور والبقرة في شرط واحد على ما كان بينهما من بعد.
الثور: ثور الوحش لا الأهلي، وبجمع على ثيران وثيرة، وثورة وأثوار وثبار.
نعجة: النعجة هي أنثى الضأن (الخروف)، ويطلق عليها أيضًا "الشاة". تُستخدم كلمة "نعجة" أيضًا للإشارة إلى البقرة الوحشية، وتكنى بها العرب عن المرأة أحيانا.
دراكا: سريعا، والدراك المتابعة أيضا.
لم بنضح: لم يعرق، فيصير كأنه قد غسل بالماء.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس المذكور في بيت سابق والى ركضه بين ثور وبقرة من بقر الوحش في طلق واحد، ولم يعرق عرقا كثيرا يغسل جسده، وادركهما دون معاناة مشقة، فقد نسب فعل الفارس الذي صاد الثور والبقرة إلى الفرس، لأنه حامله وموصله إلى مرامه وبغيته.
[65]
المفردات والمعاني:
الطهاة: الطباخون، جمع طاه.
منضج: اسم فاعل من أنضج اللحم إذا أحكم طبخه أو شيه، ونضج الثمر أو اللحم إدراك وطاب أكله، ومنضج اسم فاعل من الرباعي، فقد حذفت منه الهمزة على نحو ما رأيت في البيت رقم ٤٣ -.
الصفيف: أراد شرائح اللحم التي تصف على الحجارة المحمية لتنضج.
الشواء: هو اللحم الذي يشوي على الحجارة.
القدير: هو ما طبخ من اللحم في القدر.
معجل: اسم مفعول من العجلة والسرعة.
الشرح: المعني يقول: بعد أن بين في البيت السابق أن الفرس قد إدراك من الصيد ثورا وبقرة: كثر الصيد، فصار طباخو اللحم، وهم العبيد والخدم قسمين: بعضهم أحكم شيء بعضه على حجارة محماة، بعضهم أحكم طبخه وأجاده في قدر أسرع في طبخه ونضجه، فهو يدير أن القوم قد أخصبوا فطبخوا واشتووا من صيده.
[66]
المفردات والمعاني:
رحنا: راح ضد غدا، فالأول من الرواح وهو العشي، والثاني من الغدو، وهو الصباح.
يكاد: يقرب.
الطرف: المراد به العين الباصرة كلها.
يقصر: يعجز ويمل.
ترقي العين: تنظر إلى أعلاه، وأصل ترقي تترقي فحذفت إحدى التاءين.
تسهل: أي تتحدر إلى أسفل، كما يروي تسفل، وأصله تتسهل، فحذفت منه إحدى التاءين كما ف يسابقه.
الشرح: المعني يقول: حينما عدنا ورجعنا في المساء من الصيد تكاد عيوننا تعجز عن ضبط حسن هذا الفرس واجتلاء محاسنه وصفاته، ومتي نظرت العين في أعاليه نظرت إلى قوائمه ليستتم الناظر النظر إلى جميع جسده، أو قصر الناظر نظره عنه خوفا من أن يصيبه بالعين.
[67]
المفردات والمعاني:
الهاديات: جمع هادية، وهي المتقدمة من بقر الوحش وغيره من الصيد، والهوادي من الإبل والخيل والحمر، ومن كل شيء أوله.
النحر: موضع الذبح من الحيوان.
عصارة الشيء: ما خرج منه عصره، قال أبو نواس الشاعر العباسي "فَإِذا عُصارَةُ كُلُّ ذاكَ أَثامُ"، وأراد امرء القيس هنا ما جف من عصارة الحناء على الشعر الأبيض، وكان من عادة العرب أن يصبغوا شعورهم بالحناء.
المرجل: المسرح بالمشط، وإنما خصه بالذكر لأن الشعر إذا كان مرجلا كان فيه أنقي وأصفي وأشد.
الشرح: المعني يقول: إن دماء أوائل الصيد والوحوش على نحو هذا الفرس تشبه عصارة حناء على شعر أشيب، والغرض من ذلك وصف الفرس بالسبق، وبأنه لا يفوته صيد.
[68]
المفردات والمعاني:
ضليع: عظيم الأضلاع ممتلئها، منتفخ الجنبين.
استدبرته: نظرت إليه من خلف.
الفرج: الفضاء ما بين الرجلين.
ضاف: طويل.
فويق: تصغير فوق، وهو تصغير التقريب مثل قبيل وبعيد في تصغير قبل وبعد.
أعزل: هو الذي يميل عظم ذنبه إلى أحد الجانبيين، والأعزال هو الذي لا سلاح معه.
الشرح: المعني يقول: إن الفرس المذكور في البيت سابق الأضلاع، منتفخ الجنبين، إذا نظرت إليه من خلفه رأيته قد سد الفضاء الذي بين رجليه بذنبه الطويل، الذي قرب من الأرض، وهو غير مائل إلى أحد الجانبين، أو أن يكون قصيرا، أو يكون طويلا بطأ عليه، ويستحب فيه أن يكون سابغا قصير عظم الذنب.
[69]
المفردات والمعاني:
صاح: مرخم صاحب.
الوميض والإيماض: اللمعان.
و كلمع اليدين: كحركتهما في سرعة.
حَبِيٍّ: هو ما ارتفع من السحاب، وقال بعضهم: هو الداني، أي القريب من الأرض.
مكلل: مستدير كالإكليل، وسمي السحاب حبي لأنه يحبو بعضه إلى بعض فيتراكم، وجعله مكللا لأن أعلاه صار بمنزلة الإكليل لأسفله، والإكليل التاج، وهو شبه عصابة تزين بالجواهر.
الشرح: ويروى (أحار ترى) المعني يقول: يا صاحبي هل تري برقا له لمعان في سحاب متراكم تى صار أعلاه لأسفله بمنزلة الإكليل فلمعانه سريع كسرعة حركة اليدين الشديدة.
[70]
المفردات والمعاني:
يُضِيءُ: ينير .
السنا: بالقصر الضوء، قال تعالى: {يكاد سنا برقه يذهب بالإبصار} والسناء بالمد الشرف والمجد.
راهب: أراد به المتعبد من النصارى، وهو من يعتزل الناس في دير طلبا للعبادة.
أمال: انحرف وهوى إلى السقوط، عدل وانحرف وانصرف. ويروى أهان، أي جعله هينا بمعني أنه لا يكرمه عن استعماله وإتلافه في الوقود.
والسليط: الزيت الذي يوضع في المصباح.
الذبال: جمع ذبالة، وهي الفتيلة.
المفتل: المبرم.
الشرح: المعني يقول: إن البرق المذكور في البيت السابق يتلألأ ضوؤه. فهو يشبه في حركته لمع اليدين، أو مصباح راهب أكثر فيه الزيت الذي يغذي فتيلته المبرومة.
[71]
المفردات والمعاني:
له: الضمير يعود إلى برقا، وقعد له، أي ينظر إليه.
صحبتي: أصدقاء جمع صاحب.
(حافر وأكمام): والكل أسماء أمكنة.
بعد: بضم الباء وفتحها وسكون العين. ومعنى قوله: (بعد ما متأمل) ما أبعد ما تأملت، وحقيقته إنه نداء مضاف، فالمعنى يا بعد ما متأمل، أي يا بعد ما تأملت.
الشرح: وروي هذا البـيت كما في : قعدت له وصحبتي بين ضارج ... وبين العذيب، بعد ما متأملي
المعنى يقول: قعدت مع أصحابي تنظر ذلك البرق الذي يلمع ضوؤه بين الموضعين المسميين بضارج والعذيب نرقب مطره، فبعد السحاب الذي كنت أنظر إليه، أرقب مطره، وأشيم برقه.
[72]
المفردات والمعاني:
يسح الماء: يصبه.
كتيفة: بزنة المصغر اسم أرض ببلاد باهلة.
يكب: من الكب، وهو إلقاء الشيء على وجهه.
الأذقان: جمع ذقن، وهو مجتمع اللحيين.
دوح: جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة.
الكنهبل: بضم الباء وفتحها نوع من شجر البادية، وهو من أعظم العضاة.
الشرح: المعنى يقول: إن السحاب المشتمل على البرق المذكور في بيت سابق صب الماء في وقت الضحى بغزارة شديدة حول الموضع المسمى بكتيفة، فهو لشدة غزارته يقتلع شجر الكنهبل العظيم من أصوله، ويلقيه على أم رأسه لشدة سحه وانصبابه.
[73]
المفردات والمعاني:
تيماء: قرية في الحجاز تقع شمال المدينة المنورة.
أجما: ويروى أطما، وهما بمعنى القصر، وجمعهما آطام وآجام.
مشيدا: مبنيا.
الجندل: الصخرة العظيمة، والجمع جنادل.
الشرح: المعنى يقول: إن الغيث المذكور في بيت سابق لم يترك جذع نخلة بقرية تيماء إلا كسره، ولا قصرا من قصورها إلا هدمه، إلا ما كان منها محكم البناء مبنيا بالصخور العظيمة والجص.
[74]
المفردات والمعاني:
ذرى: جمع ذروة، وهي أعلى الشيء.
المجيمر: بصيغة المصغر أرض لبني فزازة، وقيل: هو جبل، وهو أولى.
غدوة: صباحا.
السيل: الماء الكثير المتجمع من المطر، والجمع سيول.
الأغثاء: جمع غثاء، وهو ما يحمله السيل من الحشيش والشجر والتراب وغير ذلك، ويروى غثاء بتشديد الثاء وضم الغين. وقد يراد بالغثاء ما لا ينفع فيه من الناس ولا غناء عنده. ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم : ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وقوله تعالى: والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، ي يابسا أسود.
مغزل: بتثليث الميم آلة الغزل.
فلكت: ما يكون في أعلاه مستديرا، وهو بفتح الفاء.
الشرح: المعنى يقول: إن أعلى هضبة المجيمر تشبه فلكة المغزل في الصباح، وذلك بسبب ما أحاط بها من غثاء السيل.
[75]
المفردات والمعاني:
ثبير: اسم جبل بعينه، ويروى أبانا، قال الأصمعي: هما أبانان: جبل أبيض وجبل أسود، وهما لبني عبد مناف بن درام.
العرانين: جمع عرنين، وهو معظم الأنف أو كله، وعرنين الأنف تحت مجتمع الحاجبين حيث يكون الش؟ ر، ويروى مكانه (أفانين) أي ضروب، وعلى الأول يكون قد استعار العرانين لأوائل المطر، لأن الأنوف تتقدم الوجوه، أي إنه أراد به الأول من الوبل، وهو المطر الغزير، واحده وابل، قال تعالى: {فإن لم يصبه وابل فطل} ويروى مكان وبله (ودقه) والودق.
أيضا المطر: قال تعالى: {فترى الودق يخرج من خلاله}.
البجاد: كساء مخطط من أكسية العرب يتخذ من وبر الإبل وصوف الغنم.
مزمل: ملفوف ومغطى، قال تعالى: {يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث الوحي (ملوني زملوني).
الشرح: المعنى يقول: إن ثبيرا في أوائل مطر هذا السحاب ونزوله عليه شبيه بسيد أناس، قد تلفف بكساء مخطط، فهو يشبه تغطية هذا الجبل بغثاء السيل بتغطي رجل كبير بكساء مخطط، لأن الكبير أبدا متدثر، وذلك أن رأس الجبل يضرب إلى السواد، والماء حوله أبيض.
[76]
المفردات والمعاني:
الصحراء: أرض الفلاة، وأصل صحراء صحراو، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولم يعتد بالألف الزائدة لكونها حاجزا غير حصين، فالتقى ساكنان: الألف الزائدة والألف المنقلبة، فأبدلت الثانية همزة.
الغبيط: أكمة قد انخفض وسطها، وارتفع طرفاها، وسميت غبيطا تشبيها لها بغبيط البعير، أي قتبه، والمراد بصحراء الغبيط أرض بني يربوع، وقيل: أراد كل أرض منخفضة.
بعاعه: ثقله.
العياب: الأعدال المملوءة ثيابا وبزا، مفرده عيبة.
المحمل: يروى بفتح الميم الثانية وكسرها، فمن فتحها جعل اليماني جملا، ومن كسرها جعله رجلا.
الشرح: المعنى يقول: إن المطر المذكور في بيت سابق قد ألقى ثقله بصحراء الغبيط، فأنبت الكلأ وضروب الأزهار، وألوان النبات، فصار نزول المطر به شبيها بنزول التاجر اليماني صاحب الأعدال المملوءة ثيابا وبزا، حينما ينشر أمتعته يعرضها على المشترين، وهي مختلفة الألوان.
[77]
المفردات والمعاني:
غرقى: جمع غريق، مثل مرضى ومريض، وجرحى وجريح.
العشية: ما بعد الزوال إلى غيبوبة الشفق الأحمر، وكذلك العشي والعشاء، ويقابل ذلك بكرة وبكور وغدوة وغدو، ويروى مكان (عشية) (غدية) انظر البيت السابق.
الأرجاء: النواحي، مفردة رجاء مقصور، والتثنية رجوان.
القصوى: تأنيث الأقصى، وهو الأبعد، والقصوى مثل القصيا، والياء لغة نجد، والواو لغة سائر العرب، وبها جاء القرآن الكريم {إذا أنتم بالعدوة الدنيا، وهو بالعدوة القصوى}.
أنابيش: هي أول النبت، سميت بذلك لأنها ينبش عنها، واحدتها أنبوشة.
العنصل: البصل البري، وهو بضم الصاد وفتحها، ومثله العنصر والعنصر، والعنصل شديد الحموضة لا يؤكل.
الشرح: المعنى يقول: إن السباع قد غرقت في سيول هذا المطر، فتبدو أطرافها في نواحيه مثل أصول البصل البري، فقد شبه تلطخها بالطين والماء الكدر بأصول البصل البري المتلطخة بالطين والتراب.
[78]
المفردات والمعاني:
علا: فعل ماض من العلو، وهو الارتفاع والصعود، ويروى (على قطن) بجر قطن بعلى.
بالشيم: بالنظر، يقال: شمت البرق، أي نظرت إليه.
صوبه: مطره الذي يصيب الأرض، وأيمنه يحتمل تفسرين: أحدهما أن يكون أحدهما أن يكون من اليمن، أي البركة، والآخر أن يكون من اليمين، أي جهة اليمين، وأيسره كذلك يحتمل تفسيرين: أحدهما أن يكون من اليسر أي السهولة، والآخر أن يكون من يسرته، أي جهة اليسار التي هي ضد جهة اليمين.
قطن، والستار، ويذبل: أسماء جبال في بلاد الشام، ويروى بدل (الستار ويذبل) النباج وثيتل، وهما ماء أن لبني سعد بن زيد مناة مما يلي البحرين.
الشرح: المعنى يقول: إن السحاب المشتمل على البرق المذكور في البيت رقم - ٨١ - ارتفع فوق جبل قطن، ووقع أبرك مطره عليه، وأما أيسره فقد وقع على الجبلين المسميين بالستار ويذبل، فهو يصف السحاب المشتمل على البرق بالعظم، وبأنه غزير، وأراد بقوله: بالشيم أنه يحكم به ظنا وتقديرا، لأنه لا يرى الجبال المذكورة معا، وأين هو منها؟
[79]
المفردات والمعاني:
القنان: جبل لبني أسد، يروى بفتح القاف وتخفيف النون، وضم القاف وتشديد النون.
النفيان: هو في الأصل ما تطاير من الرشاش عند الاستقاء، والمراد به هنا ما شذ عنه معظمه.
العصم: الوعول، واحدها أعصم، والأنثى أروية.
الشرح: المعنى يقول: ومر على الجبل المسمى بقنان شيء من رشاش الغيث المذكور في البيت السابق، فأنزل الوعول العصم من منازلها التي تكون مستقرة فيها، وذلك لشدة قطرة على الجبل، وعظيم انصبابه.
×
تفسير الحاشية
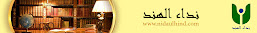
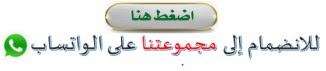







0 تعليقات
أكتُبْ تعليقا