تفاصيل عن المقالة
العنوان: جهود علماء شبه القارة الهندية في الدراسات الصوتية
إعداد : د. ضياء القمر آدم على (أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة المحمدية، ماليغاون، مهاراشترا، الهند )
المصدر: مجلة الهند
تصدر عن : مولانا آزاد آئيديل إيجوكيشنال ترست / بولفور، بنغال الغربية
رقم العدد:١
ISSN: 2321-7928
أرقام الصفحات: 222-249
المجلد : ١٠
السنة: ٢٠٢١
الدولة: الهند
تاريخ الإصدار:١ يناير ٢٠٢١
رئيس التحرير: د. أورنكزيب الأعظمي
إنّ علم العربية من أسمى العلوم قدراً، وأنفعها أثرًا؛ إذ هو المرقاة إلى فهم كتاب الله، وسنة رسوله - ولهذا حظيت الدراسات اللغوية- قديما وحديثا- بمنزلة كبيرة في صفوف المعنيين بالعربية وعلومها؛ فقد بذل رجال مخلصون من سدنة اللغة وحفظتها- في المشرق العربي ومغربه جهوداً محمودةً، ومساعي جبارةً في دراسة الجوانب اللغوية.
وفي شبه القارة الهندية- كما في غيرها من الأقطار - ظلّت اللغة العربية موضع احترام وتقدير، ولعلمائها نشاط ملموس وعناية فائقة بالعربية لغةً، ونحوا، وصرفًا، واشتقاقا، ودلالة ولهم تراثُ ضخم يستحق الوقوف عنده وتدوينه؛ إذ بدأ اهتمامهم بالعلوم اللغوية؛ منذ أن دخل الإسلام فيها؛ حسبما تشير إليه المصادر التاريخية.
وإذا كان هذا هو دأب علماء القارة في الاهتمام بهذه العلوم؛ منذ القرن السابع حتى العصر الحديث؛ فإنه من الحق أن يُشار إلى قلة حظهم في الشهرة بين علماء العربية من مشرق الوطن الإسلامي إلى مغربه؛ فمؤلفاتهم اللغوية لم يكتب لها من الذيوع والانتشار ما كُتب لمؤلفات علماء العربية في الأقطار الأخرى، ولم تذكر آراؤهم واجتهاداتهم، أو مؤلفاتهم في كتب غيرهم من اللغويين، في حين نجد آراء علماء العربية مبثوثةً في المؤلَّفات الهندية المختلفة سواءً كانوا من القدماء، أو من المتأخرين، وسواءً كانوا في المشرق العربي أو في مغربه.
وكما هو معروف لدى الباحثين اللغويين أنّ الدراسات اللغوية تشمل جوانبها الأربعة: الدراسات الصوتية والصرفية، والنحوية، والدلالية.
وخصصت هذا المقال وما سأتبعه لإبراز ما للعلماء الهنود من خدمات جليلة ومساع جبارة في الدراسات الصوتية؛ وذلك بعرض مؤلفاتهم، ومناهجهم، وتميز آرائهم ونظراتهم، واختياراتهم وترجيحاتهم واعتراضاتهم وانتقاداتهم، وإبداعاتهم وابتكاراتهم، وإضافاتهم وزياداتهم، والكشف عن اتجاهاتهم اللغوية الصوتية.
تعريف "الصوت"- لغة واصطلاحًا: "الصوت"- لغة: الجرس، صَوَّتَ فلان بفلان تصويتا؛ أي: دعاه. وصات يصُوتُ صوتا، فهو صائتُ؛ بمعنى: صالح، وكلُّ ضَرْبٍ من الأغنيات صَوتُ من الأصوات، ورجل صائتُ: حَسَنُ الصَّوت شديده، ورجل صَيتُ: حَسَنُ الصَّوتِ، وفلان حَسَن الصيت: له صِيتُ وذكر فِي النَّاسِ حَسَنُ .
أما "الصوت"- في الاصطلاح - فقد حاول العلماء المعنيون بدراسة اللغة تحديد ما يعنيه "الصوت"، فوضعوا تعريفات لهذا المصطلح تباينت بين قديمهم وحديثهم، ومن بين القدماء ابن سينا؛ الذي عرف الصوت بأنه "تموج الهواء، ودفعه بقوة وسرعة من أي سبب كان". وعرفه ابن جني بأنه "أصواتُ يعبر بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم".
أما المحدثون فمنهم إبراهيم أنيس؛ الذي عرف الصوت بأنه "ظاهرة طبيعية ندرك أثرها، دون أن ندرك كنهها".
ومن المعروف لدى اللغويين أنّ الدراسات الصوتية تشمل الدراسة الصوتية القديمة؛ التي يطلق عليها اسم "علم التجويد"، والدراسة الصوتية الحديثة، التي يطلق عليها اسم "علم الأصوات" بفروعها المختلفة. وإن كان هذا العلمان قد اتخذا في درسهما مسارينِ مختلفين؛ اختص الأول بقراءات القرآن الكريم؛ فأصبح يُدرس في قسم القرآن، واختص الثاني بكلمات اللغة العربية عامةً، فأصبح يدرس في قسم اللغة العربية؛ مع أنّ العلمين في الحقيقة- من وادٍ واحد، ويؤولان إلى أصل واحد؛ وذلك لأنّ علماء كل من "علم التجويد" و"علم الأصوات" بينوا- في مؤلفاتهم- الحالات الصوتية المختلفة، والتغيرات التي تطرأ على الصوت في أثناء النطق، وأوضحوا حالات الإدغام، والغنّة، والإمالة، وبينوا أسبابها وأحكامها، وعرّفوا الوقف، وذكروا أقسامه وأحكامه، وبينوا ظاهرة المد وأنواعه وأحكامه وغير ذلك من الظواهر الصوتية؛ مثل: الإعلال والإبدال والإشمام والإخفاء، والإظهار، وكلّ المسائل الصوتية؛ التي تترابط وتتداخل فيما بينها.
أما "علم الأصوات الحديث أو المعاصر" فيهتم- إلى جانب ذلك- بموضوعات أخرى؛ بعضها يتعلق بعلم الأصوات النطقي؛ مثل آلية إنتاج الصوت اللغوي، والمقطع الصوتي، والنبر والتنغيم، وبعضها يتعلق بعلم الصوت الفيزيائي، وعلم الصوت السمعي، و بعض هذه الموضوعات يحتاج إليه دارس علم التجويد- أيضا.
ظهور التأليف في الأصوات عند العرب: يعود تاريخ الاهتمام بالصوت إلى عهدِ تقعيد علماء العربية القواعد وتأسيسهم النحو؛ بل يكاد يسبق ذلك. ولعلّ خبر أبي الأسود- حين وضع رموز الحركات يُجلي شيئًا من هذه الأولية؛ وهو أنه جاء "إلى زياد؛ فقال له: ابغني كاتبا يفهم عني ما أقول؛ فجيء برجل من عبد القيس؛ فلم يرض فهمه؛ فأُتِي بآخر من قريش؛ فقال له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على أعلاه، وإذا ضممتُ في فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإذا كسرت في فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئًا من ذلك غنّةً فاجعل النقطة نقطتين؛ ففعل؛ فهذه نقط أبي الأسود"، ومن هنا نشأت ألقاب الحركات في العربية، وعدَّت من أكثر ألقاب الأصوات توفيقا.
مضى علماء العربية يؤلفون في النحو والصرف والمعاجم مشوبين بأحكام الصوت وعلله؛ فالخليل بن أحمد الفراهيدي هو من ألف أوّل معجم في العربية؛ وهو كتاب "العين"، الذي بُني على أساس صوتي، وصدّر المؤلّف بمقدمة صوتية تعدُّ أَوَّلَ دراسة صوتية منظمة، وصلت إلينا في تاريخ الفكر اللغوي عند العرب.
ثم تلاه كتاب سيبويه الذي تضمن دراسات صوتيةً، أوفتْ على الغاية دقةً وأهمية، وتنوعت بتنوع مادتها فكان منها ما يتعلق باللهجات والمقايسة بينها، والاستدلال لها، ومنها ما يعرض للقراءات، ومنها ما يتحدث عن ظواهر صوتية، كأحكام الهمز؛ من التحقيق والتسهيل، والإمالة والفتح، وما يتعلق بهما من أحكام، والإعلال، والإبدال، والتعليل الصوتي لهما، ثم تتابعت كتب النحو واللغة بعد سيبويه تنحو نحوه، وتقفو أثره؛ في تخصيص حيّز للدراسات الصوتية، مرددةً تعبيراته ومصطلحاته في كلّ ما يتعلّق بمخارج الحروف وصفاتها.
وهكذا اختلطت بحوث الصوت بالنحو والصرف إلى حد؛ ضاع فيه كثير من معالمها أو كاد، غير أنها عادت لتبرز على نحو واضح في علم آخر نشأ في رحاب القرآن خدمةً له، وصونًا لترتيله وتلاوته، وحفظًا لوجوه أدائه؛ وهو علم وهو علم التجويد؛ وأول من صنف فيه- على ما يبدو- موسى بن عبيد الله بن خاقان؛ صاحب "القصيدة الخاقانية" في التجويد.
أما علم الأصوات، فظهرت بوارد التأليف فيه في العربية على يد المستشرقين في النصف الأول من القرن العشرين، لكنّ أوّل مؤلف كتب بالعربية- في العصر الحديث- هو كتاب "الأصوات اللغوية"، للدكتور إبراهيم أنيس؛ الذي صدرت طبعته الأولى في القاهرة سنة 1947م، ثم توالت المؤلفات فيه، وتكاثرت بعد ذلك.
وإذا انتقلنا إلى شبه القارة الهندية لنُسجّل ما شهدته الدراسات الصوتية من بواكير ونشاطات، فنجدها تبدأ منذ أن بزغت شمس الإسلام في ربوعها؛ حيث أقبل المسلمون الهنود على القرآن الكريم كلّ الإقبال تعلماً وتعليما، درسًا وتدريسًا، تحفيظا وتلقينا، ومن ثم أنشئتِ الحلقات القرآنية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكان التركيز- بصورة خاصة على الفنون والتخصصات ذات الصلة بالقرآن الكريم؛ مثل: التجويد، والقراءات القرآنية. ويذكر المؤرخ ضياء الدين البرني أن مهرة القرآن الكريم- في فني القراءة والتجويد؛ في هذه البلاد- هم أمثال: علاء الدين المقرئ، والخواجه زكي، وغيرهما ممن عزّ نظيرهما في مناطق معروفة بالعلم؛ مثل: العراق، وخراسان، وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي، إلا أنّ هذه البواكير والنشاطات في ذاك ! العهد المبكر لم تدوّن في صحيفة، ولم تسجل في كتاب، ولم تصل إلينا معلومات عنها.
فإذا تصفّحنا كتب الثقافة الإسلامية لشبه القارة نجد أنّ أوّل مؤلّف في الدراسات الصوتية في شبه القارة يرجع إلى القرن السابع الهجري؛ حيث ظهر فيه عالم لغوي فذ تصدّى لتأليف كتب جمةٍ في فنون مختلفة؛ من بينها: علم التجويد؛ ألا وهو: الصَّغاني؛ الذي ينسب إليه كتاب في التجويد ، ثم استمرت بعد ذلك- عناية العلماء والمعلمين والمؤلفين والمحققين بهذا العلم وقواعده وأحكامه، وتعليماته وتوجيهاته؛ حتى تكونت بذلك مكتبة واسعة فيه.
إنّ الدراسات الصوتية في شبه القارة الهندية تناولت بشرح قضاياها ومسائلها وأحكامها كتب في علم التجويد، وكتب في النحو والصرف واللغة.
أما أهم مؤلفات علم التجويد التي عولجت فيها مسائل الأصوات فهي ما يلي:
.1 شرح الشاطبية، للشيخ محمد بن منَّ الله الصديقي الكاكوري (ت1002هـ).
2 الدر الفريد في القراءة والتجويد، للشيخ عبد الحق الدهلوي (ت1052هـ).3
3 حلية القاري للسيد أحمد الحسيني (ت1105هـ).4
.4 زينة القاري للمولوي كرامت علي الجونفوري (ت1290هـ) بالأردية.
5. رغائب الألباب، لرضا علي بن سخاوت البنارسي (ت1312هـ) بالفارسية.
6. فوائد مكية، للقاري عبد الرحمن المكي (ت1349هـ) بالأردية.
7. جمال القرآن، لأشرف علي التهانوي (ت1362هـ) بالأردية.
8. خلاصة التجويد، لضياء الدين احمد الإله ابادي (ت1371هـ) بالعربية.
أما كتب النحو والصرف واللغة التي تناولت مسائل وقضايا ذات صلة بالدراسات الصوتية فمن أهمها:
1. الشوارد، للصغاني؛ حيث تحدث فيه المؤلّف عن التغيرات الصوتية؛ كالحذف، والإبدال، والإعلال، والإدغام، والإمالة؛ التي تطرأ على الكلمة.
2. شرح الفصول الأكبرية، لعلي أكبر الإله آبادي؛ خصص المؤلّف جزءا كبيرًا منه للحديث عن المباحث الصوتية، وما يتعلق بها من القضايا كالإمالة، والإبدال والإدغام وبين بين، والحذف والرد، والقلب، والتحريك، والإسكان، كما تحدث عن مخارج الحروف وصفاتها.
3 وسيط النحو، للشيخ تراب علي بن نصرة الله الخير آبادي؛ حيث خصص الفصل الثامن من الكتاب للحديث عن الإمالة، والفصل التاسع لالتقاء الساكنين، والفصل العاشر للوقف.
.4 فقه اللسان، لكرامت حسين الكنتوري، وتعرّض المؤلّف فيه لبعض المباحث والقضايا الصوتية كنشأة الألفاظ من أصوات، وأسباب كثرة البدل في العربية، وكون الأصوات السينية والرائية أسبق في الوجود على غيرها، ثمّ الأصوات الأصلية، والمصادر الأصلية، وما طرأ عليها- بعد ذلك- من تغييرات بالاشتقاق اللغوي والصرفي.
5 كتاب المبين، للسيد محمد سليمان أشرف (ت1358هـ) بالأردية، وقد تحدث فيه عن مخارج الأصوات العربية، وصفاتها في الباب الأول والثاني من كتابه، وعلاقة الصوت المفرد والمركب بالمعنى.
أمّا علم الأصوات الحديث في شبه القارة الهندية فلم ينل اهتمامًا كبيرًا، وعنايةً فائقة؛ كما نالت فروع الدراسات اللغوية الأخرى: النحوية، والصرفية، والمعجمية؛ ولذلك لا نرى تأليفًا مستقلا في هذا العلم؛ لعدة أسباب:
الأول: يرى علماء العربية في شبه القارة- أنّ المباحث الصوتية؛ كالإدغام، والغنّة، والإشمام، والروم، والوقف والإبدال، وغيرها، أشدّ التصاقا بعلم التجويد؛ الذي يتعلق بالآيات القرآنية وكلماتها وألفاظها فحسب، ولا تتعدى إلى غير ألفاظ القرآن الكريم، ولذلك أصبح هذا العلم وما يتعلّق به من المباحث مقصوراً في تدريسه على حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
الثاني: أنّ هذا العلم لم يظهر في أرض العرب إلا في وقت متأخر، لا يربو على أكثر من قرن، وأغلب الظن أنّ أوّل كتاب في هذا اللون كما سبق- كتاب "الأصوات اللغوية" للدكتور إبراهيم أنيس؛ الذي كانت طباعته الأولى في سنة 1947م، كما لم يظهر في شبه القارة إلا في وقت قريب لا يتجاوز ثلث القرن؛ حيث نجد بعض البحوث والمقالات والأطروحات العلمية ذات الصلة بالأصوات كُتبت لنيل الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه) في بعض الجامعات الهندية؛ ومن تلك البحوث
- الكمية في الأصوات الصامتة في اللغة العربية، للباحث: أحمد مسعود عيسى العزابي، تحت إشراف الدكتور محمد ثناء الله الندوي بجامعة علي كره، سنة 2005م.
- دراسة صوتية عن الهمزة وإبدالها، للباحث: عبد المتين أشرف، تحت إشراف البروفيسور فضل كبريا الصديقي، بجامعة بتنه.
- تشكيل المقررات الدراسية للأصوات العربية لطلاب مرحلة "البكالوريوس" بولايةآسام، للباحث: محمد جهانغير عالم، تحت إشراف الدكتور سيد راشد نسيم الندوي، بجامعة اللغة الإنجليزية سنة 2007م.
الثالث: ومن أسباب عدم الاهتمام والعناية بعلم الأصوات أنّ ن قسم اللغة العربية في قسم الجامعات الهندية- منذ إنشائه حتى الآن يركز على تدريس المواد المتعلقة بالأدب العربي، وعلى فن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والعكس، ولايزال القسم ضعيف العناية بجوانب اللغة ذاتها: صوتيةً، وصرفية، ومعجمية، ودلالية، ولأجل هذا لا نكاد نجد مادةً من المواد المرتبطة بالأصوات داخلة في المقررات الدراسية في مراحلها المختلفة (البكالوريوس)، و(الماجستير)، و(الدكتوراه).
هذا ما يتعلق بالدراسات الصوتية تاريخها، وظهورها، وبعض مؤلفاتها في شبه القارة الهندية التي عرضت في بعض صفحاتها مسائلها وقضاياها وأحكامها.
أما المناهج التي سلكها علماء هذه المؤلّفات فاخترت لبيانها ثلاثة مؤلفات؛ إذ أراها تعد من أهم المؤلفات في هذا الباب.
الأول: فقه اللسان للكنتوري (ت 1335هـ) بالعربية.
الثاني: فوائد مكية، لعبد الرحمن المكي (ت1349هـ) بالأردية.
الثالث: جمال القرآن، للشيخ أشرف علي التهانوي (ت1362هـ) بالأردية. وقبل أن أتعرض لمناهج المؤلفين في مؤلفاتهم أود أن أقدم التعريف بالمنهج لغة واصطلاحًا.
التعريف بالمنهج لغة: قال ابن فارس: "النون، والهاء، والجيم، أصلان متباينان؛ الأول: النهج الطريق، ونهج لي الأمر: أوضحه وهو مستقيم المنهاج، والمنهج: الطريق- أيضًا، والجمع المناهج. والآخر: الانقطاع، وأتانا فلان ينهج؛ إذا أتى مبهورا، منقطع النفس"، وتكاد تنفق المصادر على أن مادة (نَهَجَ) وما تصرف منها يرجع أصلها إلى الطريق الواضح، وأنّ النهج، والمنهج، والمنهاج، بمعنى واحدٍ، ويجمع كل منها على: (مناهج)".
أما (المنهج) اصطلاحًا فقد عُرف بعدة تعريفات؛ منها:
أنَّ المنهج العلمي في التأليف، هو: "فن التنظيم الصحيح، لسلسلة الأفكار العديدة؛ من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين؛ حين نكون بها عارفين".
أنَّه هو "خطوات منظمة، يتخذها الباحث في البحث العلمي لمعالجة مسألة أو أكثر، ويتّبعها؛ للوصول إلى نتيجة".
أنه هو: "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم؛ بواسطة طائفة من القواعد
العامة؛ التي تهيمن على سير العقل، وتحدّد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة معلومة".5
وهذه التعريفات وغيرها يمكن أن تقيد بأنَّ المنهج العلمي هو: خطوات منظمة يتبعها الباحث، تتعلَّق بالنَّواحي العلمية والشكلية كالوصفية والتاريخية والمقارنة، والتوثيق، وإيراد المصادر، وغيرها من القضايا التي يتحقق بها الهدف من إجراء البحوث العلمية.
أولا: منهج المؤلف في كتاب "فقه اللسان": التعريف بالكتاب:
كتاب "فقه اللسان" بالعربية في ثلاثة مجلدات خصَّص المؤلّف الجزء الأول منها للحديث عن القضايا الصوتية، وما يتعلق بها من أحكام، فبدأه بمقدمة، ثم عقد فصولا لبسط الحديث عن المسائل المتعلقة بالأصوات.
أما المقدَّمة فأبدى فيها الغرض المقصود من تأليف هذا الكتاب.
أما الفصول فقد عقد لكل منها عنوانًا، ثم سرد تحته قضايا لغويةً- في أكثر الأحيان؛ وهذه أهم فصول:
فصل: في أصل اللغة العربية: ذكر المؤلف فيه أنّ العربية من اللغات السامية، وأنها تتقدم على العبرانية والسريانية؛ مع ذكر دلائل التقدم.
فصل: في خواص المفردات من الحركة، والوزن النوعي، والسلامة، والتفاوت في عدد العلاقات، والجذب ،وغيرها، وبيان معنى الجمود والسيلان والبخارية.
فصل: في تأليف الحيوانات من قطرات المادة الأولى.
فصل: في امتياز المدركة من سائر البدن.
فصل: في أنّ الاسم والفعل والحرف فرقُ ممتازة من الصوت.
فصل: في الإدراك وفي درجاته.
فصل: في تفاوت المدركات والمدركات.
وساق المؤلف فيه عدة مسائل لغوية؛ أهمها: (1) تغير الأسباب الخارجية الحواس والمحسوسات (2) الاختلاف في الأبدان والطبائع يحدث بمعاملة الأسباب الخارجية والداخلية (3) اختلاف الأسباب يحدث الاختلاف في أدوات الكلام والسماع، (4) تفاوت الأسباب هو السبب الأول لاختلاف الألسنة، (5) الاستعانة بإحضار السبب الخارجي هي الدلالة (6) الدلالة تقريب بين المدلول والمدلول إليه، (7) خصال الدلالة (8) إحضار الأوصاف منحصر في التمثيل،
(9) التمثيل: إما تمثيل الصورة أو تمثيل الصوت، والأول هو التصوير، والثاني هو التصويت، (10) امتياز التصوير في النحت، والنقش، والخط، (11) كون الحروف في بدو نشأتها صور الماديات (12) أسامي الحروف السريانية أسام ماديات (13) الخط السرياني مأخوذ من الخطوط العربية واليونانية وغيرهما، (14) كانت الألفاظ عند حدوثها أصواتا حاكيةً للمسموعات، (15) لا يدلّ صوتُ على جسم بدون أن تكون بينهما مناسبة، (16) المناسبة وجود صوت مع ذلك الجسم، (17) دلالة الصوت بالذات على الصوت الملازم للجسم، ثم على الجسم، ثم على صفاته، ثم على المعقولات (18) المماثلة بين الحاكيات والمحكيات غير تامة، (19) الفرق بين الحكاية بالتصوير والتصويت (20) التصويت قاصر في الحكاية، (21) طول الاستعمال يحكم الملازمة بين الصوت الدال والجسم المدلول إليه (22) الأسباب الداعية إلى ترك الحركات والرمزات (23) البحث في تقدّم
الاسم على الفعل وضعا؛ كالبحث عن تقدم المادة على القوة، (24) الصوت المادة الأولى للألفاظ (25) يمكن بيان نسب بعض الألفاظ، ولا يمكن بيان نسب الجميع لأمور، (26) المراد بالألفاظ النقلية (27) رأي الحكيم إسبنسر في حدوث اللغة، (28) لا بد من بيان كيفية حدوث المادة الأولى للغة.
فصل: في المادة الأولى للغة: وتناول المؤلّف فيه عدة مسائل؛ أهمها: (1) أنه لا تمتاز الأصوات المختلفة إلا إذا حدثت في الأذن قوة إدراكها، (2) السامعة في الأقوام العالية تدرك الفرق بين السين والشين وغيرهما، (3) يتخيل في الصدمات صوت أو رائيُّ، أو نوني، أو مكرر، وغير ذلك، (4) الأصوات السينية والرائية سيني، وغيرهما؛ كالقطرات من المادة الأولى (5) امتياز الصوت المعين في صوت حرفين، (6) الداعي إلى كثرة الأصول الثلاثية في الساميات، (7) صورة الصوت المتصل في الحكاية ومرتبتها، (8) كيفية حدوث الثلاثي المضاعف والرباعي المضاعف، (9) توفیق حالات المادة الأولى من اللغة بحالات المادة الأولى من الحيوان.
فصل: في بيان التغيرات الطارئة على المصدر الأصلي: وتحدث المؤلف فيه عن مسائل لغوية؛ منها: (1) تقسيم الاشتقاق إلى الصرفي واللغوي، (2) البدل من الاشتقاق اللغوي (3) كثرة البدل في العربية، وسببه، والأمثلة عليه، (4) البدل في السريانية والعبرانية (5) من الاشتقاق اللغوي: القلب، والداعي إليه، (6) الفرق بين العربية واليافثيات في الاشتقاق الصرفي، (7) المادة الأولى للاشتقاق الصرفي، (8) حروف (أمان وتسهيل) صور الإعراب.
فصل: في الاشتقاق اللغوي الذي به يصير المصدر الأصلي رباعيا وخماسيا: وساق المؤلّف فيه الحديث عن مسائل؛ أبرزها: (1) القائل بالكون في المخترعات مضطر إلى القول بأن الأبسط من الأبنية أصل، والباقي فرعه، (2) أمثلة حصول الرباعي الثلاثي. والخماسي من فصل: في أنَّ الاشتقاق اللغوي لا قياس فيه، وأنّ المشتقات اللغوية لا تكون على أوزان موضوعة. وجاء الحديث فيه عن مسائل؛ منها: (1) أمثلة الكلمات الموزونة بأوزان عديدة (2) أصول العلاقات التي بها ينتقل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. فصل: في بيان الطريقة المرسومة لجمع اللغات في كتب اللغة: تحدث المؤلف فيه عن مسائل؛ أبرزها: (1) اعتناء القدماء بالظاهر أكثر من اعتنائهم بالباطن، (2) الجمع المكاني مما لا بد منه في اللغة، ولكنه قاصر في أمورٍ.
فصل: في بيان الأسلوب؛ الذي ينبغي مراعاته لجامع اللغات: وتحدث المؤلف فيه عن عدة قضايا أهمها (1) الأسلوب الذي اختاره في ذكر بعض المصادر، (2) أمور ترشد المؤلف إلى الأسلوب المختار، (3) الترتيب؛ الذي رتب فيه المعاني. أما المجلدان الآخران فتحدَّث المؤلّف فيهما عن المصادر الأصلية، وما تتفرع عنها من المصادر الفرعية، وكيفية حدوث المصادر الفرعية عن الأصلية، والعلاقة بين معاني الأصلية ومعاني الفرعية، والمناسبة بين الكلمات ومعانيها.
ويمكن استخلاص منهج المؤلّف في الكتاب من النقاط التالية:
أولًا: بدؤه كتابه بمقدمة خالية من الحمد والثناء الله، والصلاة والسلام على النبي؛ كما هو دأب المؤلفين القدامى والمحدثين؛ وإنما دخل في الحديث عن الغرض المقصود لتأليف الكتاب؛ فقال: "أريد أن أذكر في هذه الوجيزة- ماهية اللسان العربي، وحديث تكون مصادرها، وأن أنسب المصادر، وأترجمها مميزا بين المصادر الأصلية والفرعية، وبين المعاني الحقيقية للمصادر ومشتقاتها، والمعاني المجازية لها؛ باحثًا عن أسباب".
ثانيا: يباشر النقل عمن سبقه من اللغويين، ولا يأتي بتوطئة، تشعرنا بالمقصود من عقد الفصل، ومن الأمثلة على ذلك قوله: "فصل: في أصل اللغة العربية:
ثالثا: قال يوسف داود الموصلي في كتابه: "في نحو العربية" أنّ اللغة؛ التي تستعمل في هذه المدينة، وفي معظم البلاد الغربية الجنوبية من آسيا، وفي مصر، وسائر البلاد الشمالية من إفريقية، وفي غير ذلك من الأمصار، تسمّى اللغة العربية نسبةً إلى العرب". يرتح في المسائل الخلافية ما يراه راجحا، ويضعف قول الآخرين، الأمثلة ومن على ذلك قوله: "قد اختلف المذاهب في القول: أي من جميع هذه اللغات السامية الأصلية؟ لأنه لا شك في أنّ كلَّها نبعث من أصل واحد، فزعم كثير من القدماء أن أقدم هذه اللغات وأمهن هي العبرانية، وزعم كثير- ولا سيما المتأخرين من المشرقيين - أنَّ أقدمهن هي السريانية، ولكن الرأي الصحيح دون غيره- على علمي- وهو أنّ العربية هي أقدم من سائر اللغات السامية، وأقرب كلّهنّ، وأدلة ذلك كثيرة، ونحن نذكر- ههنا- أخصها".
رابعا: يلاحظ أنَّ المؤلّف في كثير من الأحيان- يورد الاعتراض، ثم يجيب عنه، ومن الأمثلة على ذلك قوله: "لعلّ معترضًا يعترض قائلًا: كيف يمكن أن تكون العربية أصل اللغات السامية، والعبرانية والسريانية من فروعها، ونحن نعلم أنَّ اللغة العبرانية كانت مكتوبةً، منذ الأحقاب القديمة، وقد كتب فيها أول كتاب، وصل إلى عهدنا من دون سائر اللغات، والسريانية كانت شائعة في الدول الكثيرة... فنجيب أنّ هذا كله لا يُبين أنّ اللغة العربية أحدث أنّ اللغة العربية أحدث من العبرانية والسريانية فقط، بل إنه لم يكن لها علوم وكتب، إلَّا بعدهما بكثير من الأجيال؛ فإنّ العرب كانوا لم موجودين في بلادهم، منذ الدهور القديمة؛ فكانوا إذا يتكلمون بلسانهم منذ الدهور القديمة، ولولم يقرؤوا ويكتبوا مثلما السريان والعبريون كانوا في بلادهم منذ سنين كثيرة. لا، بل نقول: إنه من المحتمل أن العرب والسريان والعبرانيين كان لهم جميعاً- في الأصل- لغةً واحدةً .....!
خامسًا: ومن أسلوب المؤلّف أنَّه يحيل المسألة إلى ما سبق، أو إلى ما يأتي بقوله: " ذكرت في موضعها"، أو "لأسباب مذكورة "، أو "سيأتي تفصيلا - إن شاء الله"، ومن أمثلة ذلك قوله:
"أخذ قدماء السريانيين صنعة الخط بالصور من أهل مصر؛ أسامى حروفهم أسامى ماديات موجودة في الخارج، باؤهم بيت، وجيمهم جمل، ودالهم يد، وسينهم سن، وعينهم عين، وقافهم تحف، ونونهم نون؛ أي: سمك، وكذا الباقي من حروفهم، كانت باؤهم؛ التي تسمى في السريانية: "بيت" بمعنى: البيت تصويرا للبيت بأربعة جدران وباب، وكأنها كانت في أول الأمر دالة على بيت معين، ثم على نوع البيت، ثمّ لأسباب- ذكرت في موضعها- قامت مقام علامة، تدلّ على الصوت؛ الذي يبتدئه اسم البيت".
سادسًا: أنه يتعرض لمعنى الكلمة بالعبرانية والسريانية، بعد الذكر بالعربية، وهذه ظاهرةً عامَّةُ، تَلَاحَظُ فى الكتاب كله، ومن الأمثلة على ذلك قوله: "السير: الذهاب في حديث حذيفة: "تساير عنه الغضب"؛ أي: سَارَ وزَالَ، سار القوم يسيرون... وسير: في العبرانية: الغَلَيان، والبلبلة، والقدر لمكان الغليان.
وسير- في السريانية: السفيف؛ وهو النسيج من الخوص، وقد يراد به نفس الخوص، وسير- أيضًا - الشَّسع، وأيضًا- القدَّ، وأيضًا - السَّدي من الثّوب، و(سير) أيضًا- التراب الرقيق، أصله القد، ثمَّ الشَّسع ، ثم الخوص، وأما التراب الرقيق فلا أدري العلاقة".
سابعا: يعقب العلماء القدامى فيما قالوه؛ حيث إنه ينقل كلام العلماء، ثم يعقب بقوله: "أقول، ومن الأمثلة على ذلك قوله : كنهف عنا: مضى وأسرع، والنون زائدة؛ كذا في "القاموس".
أقول: كنهف مأخوذ من كنف؛ لأنَّ معنى كنف عنه: عدل؛ وهذا بعينه موجود في: كنهف، والقول بأنّ النُّون زائدة يشير إلى أن أصله: كهف؛ وهذا وهم؛ لأنَّه لا يوجد العدول عن شيء في معاني كهف، وأيضًا - لا يستعمل: كهف عنا" .
وقوله:- أيضًا:
"الرشف- كما في: "القاموس": الماء القليل يبقى في الحوض؛ وهو وجه الماء؛ الذي ترشفه الإبل بأفواهها، والرَّشِيف كـ (أمير) : تناول الماء بالشفتين، ورَشَفَه يَرْشُفه
كنَصَرَه وضربه وسمعه - رَشْفًا: مصه، كارتشفه وترشّفه ورشّفَه.
أقول: لا ريب في أنَّ الهِرْشِفَة مأخوذة من: الرشف؛ الذي هو مصدر أصلي؛ وضع بحكاية صوت يسمع عند الرشف، واشتقاق الهرْشِفَّة من: الرَّشْف، واشتقاق الهرْشِفَّة من: الرشف من غرائب آثار
البدل ،والقلب، إلَّا أنَّه ليس بأشدَّ غرابةً من حدوث الإنسان من المادة الحيوانية، الأولى أصل الهرشفة: الخرقة الراشفة صار تلفظها بالإدغام: أَرَاشِفَه على وزن: أفاعله، ثم ببدل الألف بالهاء صارت: هَرَاشِفَة على وزن: هفاعلة، ثم بتغيير الحركات، وسقوط الألف، ونقل الشَّدَّة من الفاء إلى اللام، صارت: هِرْشَفَّة على وزن: هِفْعَلَّة، وغير خاف على الناقد المتأمّل أنَّ القول بأنَّ الهِرْشِفَّة مأخوذةً من: الرَّشْف خير من القول بأنها كلمةً موضوعةً على حدة غير مشتقة من الثلاثي.
ثامنا: يدعم المؤلّف ما يختاره من أقوال في مسائل خلافية باستشهاده بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وأشعار العرب وهذا أسلوب عام يُلاحظ في الكتاب كله.
تاسعا: يعتني ببيان المصدر الأصلي، وما يتفرع منه من مصادر؛ فهو يذكر مصدراً يعده أصلياً، ثمَّ يُدرج تحته مصادر يعدها فرعيَّةً مشتقةً منه، ومن الأمثلة على ذلك قوله: جرر: مصدر أصلي، يحكي صوتا يسمع عند جر غصن يابس ذي شوك على الأرض...".
ثم يأتي بعدة مصادر؛ مثل: جنن، كنن، جنى، زنا، جرم، سر، صار، ويعد كلا منها مشتقةً ومتفرعة عن ذلك المصدر الأصلي.
ولكن ما المصدر الأصلي؟، وكيفية حدوثه؟، وما المصدر الفرعي؟، وكيفية تفرعه منه هذا ما سنتحدث عنه في المقال الذي يتبع.
بعد عرض نماذج الكتاب، ومناهج المؤلّف فيه يتّضح لنا أنَّ الكتاب يشير إلى سعة اطلاع مؤلّفه على العلوم العقلية، والفلسفة اليونانية، علاوةً على العلوم اللغوية خاصةً ما يتعلَّق منها بالأسرة السامية فليس الكتاب بحثاً في مصادر العربية وحدها، بل هو بحث شيّق في اللغات السامية؛ مما يضيف إلى قيمته العلمية؛ وهذا في ذاته فريد في شبه القارة، التى تسيطر عليها علوم لغاتها الآريَّة؛ ولذلك قال عبد الحي الحسني "لعله متفرد في علماء الهند لهذا الصنف".
وقد ساعد الكتاب وصاحبه في الوصول إلى هذا الأوج من المجد شُغله في منصب أستاذ القانون بجامعة إله آباد، وجامعة عليكره التي حملت مشعل التجديد اللغوي العربي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين في شبه القارة، كما ساعده أيضًا عمله قاضياً بالمحكمة العليا بإله آباد؛ حيث إنه استفاد من الحجج القانونية، والاستدلال العقلي، الذي نمى شخصيته، وترك انطباعاته في تأليف الكتاب.
ويمكننا أن نخلص مما سبق من بيان جوانب أسلوب المؤلّف في تصنيف كتابه إلى أنَّ منهجه كان يقوم على الوصف والتحليل؛ أي أنه كان قريباً من المنهج الوصفي الحديث. الكتاب الثاني: فوائد مكيَّة؛ وهو باللغة الأردية لعبد الرحمن المكي؛ وبناه مؤلفه على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
ففي المقدمة ذكر حقيقة التجويد. وفي الباب الأول خمسة فصول: الأوَّل: في حكم الاستعاذة والبسملة، والثاني: في بيان مخارج الحروف، والثالث: في بيان صفات الحروف، والرابع: في بيان الصفات اللازمة، والخامس: في بيان الصفات المميزة المزينة.
والباب الثاني يحتوي على ثمانية فصول: الأول: في بيان التفخيم والترقيق، والثاني: في أحكام النون الساكنة والتنوين والثالث: في أحكام الميم الساكنة، والرابع: في بيان حرف الغنة، والخامس: في أحكام هاء الضمير، والسادس: في بيان الإدغام، والسابع في أحكام الهمزة والثامن في بيان أداء الحركات، وكيفيتها.
والباب الثالث مشتمل على أربعة فصول: الأول: في اجتماع الساكنين وأحكامه، والثاني: في أحكام المد والثالث: في مقادير المد، والرابع: في أحكام الوقف.
والخاتمة مشتملة على فصلين: الأول: في بيان أنه لا بد للقارئ والمقرئ أن يعرف أربعة علوم، هي علم التجويد، وعلم الوقف، وعلم الرسم، وعلم القراءات المتواترة، والثاني: في حكم التغني واللهجات.
ويمكن أن يستخلص منهج المؤلف في الكتاب مما يلي:
أولا: بدء المؤلف كتابه بمقدمة بدأها بالحمد والثناء الله - عزّ وجلّ- والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فيها حقيقة التجويد، وحكمه،
- والآثار المترتبة على تركه فيقول: "اعلم أن قراءة القرآن الكريم بالتجويد حتم لولم يُقرأ القرآن الكريم بالتجويد ليعد قارئه مخطئًا، ثم إذا أخطأ، فغير حرفا مكان حرف، أو زاد حرفًا ونقص، أو أخطأ في حركة، أو سكن متحركا، أو حرك ساكنا فيعد قارئه مخطئًا. 3
ثانيا: أنه يدخل في ذكر المقصود بعد عقد الفصول مباشرةً، ولا يأتي بتمهيد ولا بمقدمة تشعر بما يوضح مقصود الباب أو الفصل، ومن أمثلة ذلك قوله:
الفصل الثالث: في بيان الصفات: معنى الجهر: الشدة، والقراءة بصوت قوي، ضده همس؛ أي القراءة بصوت خفي، وحروفه عشرة؛ مجموعها: فحته شخص سكت، وما سواها مجهورة، وللشَّديدة ثمانية حروف مجموعها: أجد قط بكت، ينحبس الصوت عند إسكانها".
وقوله في التفخيم والترقيق: "الفصل الأول: في بيان التفخيم والترقيق: الحروف المستعلية تفخّم دائماً، والحروف المستفلة ترقّق، إلا أنَّ الألف، ولام لفظ الجلالة، والراء تفحم أحيانًا، وترقق أخرى، وتفخّم الألف؛ إذا كان قبلها حرف مفخّم، وترفّق؛ إذا كان قبلها حرفُ مرقّقٌ، وتفحم لام لفظ الجلالة (الله)؛ إذا كان قبلها ضمةً أو فتحة، وترفّق؛ إذا كان قبلها كسرة، مثل: (الله)".
ثالثا: يأتي بعد القاعدة العامة بـ"فائدة"، يذكر فيها ما استثني عن القاعدة، أو ما يعدّ زيادةً على القاعدة، ومن أمثلة ذلك قوله- بعد أن ذكر أنَّ أمثلة ذلك قوله- بعد أن ذكر أن مخارج الحروف أربعة عشر: فائدة: هذا (أربعة عشر مخرجًا) مذهب الفراء، وعند سيبويه ستة عشر مخرجاً؛ لأنه أسقط مخرج الجوف؛ الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة، ووزّع حروفه على مخارج الحلق واللسان والشفتين، وعند الخليل سبعة عشر مخرجا، لأنه أثبت مخرج الجوف في مكانه وجعل حروف المد ثابتةً فيه لم توزّع، وكذلك أثبت لكلّ من اللام والنون والرَّاء مخرجًا مستقلاً"
وقوله في بيان التقاء الساكنين:
الفصل الأول: في بيان التقاء الساكنين: التقاء الساكنين على قسمين: الأول على حده، والثاني على غير حدّه. الأول: أن يكون الساكن الأول حرف مد، والساكنان في كلمة واحدة؛ مثل: (دابَّة)، (الآن)، والتقاء الساكنين هذا جائز، والتقاء الساكنين على غير حده لا يجوز، إلا في حالة الوقف، والتقاء الساكنين على غير حده: هو أن لا يكون الساكن الأول حرف مدّ، ولا الساكنان في كلمة واحدة، فإذا
كان الساكن الأول حرف مد فيحذف مثل: "وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ... وإذا لم يكن الساكن الأول حرف مدّ حُرِّك حركة الكسر؛ مثل: "إنِ ارْتَبْتُمْ".... إلَّا إذا كان الساكن الأول ميم جمع فيضم؛ مثل: "عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ"، وإذا جاء حرف ساكن بعد "من" الجارة تفتح النون؛ مثل: "مِنَ الله.
فائدة: في: "بِئْسَ الِاسْمُ" من سورة الحجرات، وردت بعد "بِئْسَ" لام مكسورة، بعدها سين ساكنة، والهمزة؛ التي قبل اللام، وبعدها همزة الوصل؛ فلذا حذفت، وكسرت اللام؛ بسبب التقاء الساكنين.
فائدة: الكلمة المنونة؛ أعني الكلمة التي في آخرها ضمتان، أو فتحتان، أو كسرتان، تقرأ فيها نون ساكنةً واحدةً، ولا تكتب ويسمّى مثل هذه النون نونًا منونةً؛ يحذف هذا التنوين في الوقف، إلا إذا كان المنون تنوين فتح؛ فتقلب ألفًا؛ مثل: "بَصِيرًا"، أما في غير الوقف، فإن كان بعدها همزة الوصل؛ فتحذف، ويصير هذا التنوين كسرة، بسب التقاء الساكنين على غير حدّه، وتكتب نونًا صغيرةً في أكثر المواضع، على خلاف القياس؛ مثل: "بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبٍ".
ويمكننا أن نخلص مما سبق إلى أنَّ منهج المؤلّف في الكتاب كان قريباً من المنهج الوصفي كذلك.
الكتاب الثالث: (جمال (القرآن) للشيخ أشرف التهانوي، وهو أول كتاب في علم التجويد باللغة الأردية في شبه القارة الهندية، وقد نقلت هذه الرسالة إلى اللغات المختلفة منها: العربية والفارسية، والبنغالية، والغجراتية.
وتشتمل هذه الرسالة على أربع عشرة لمعة: ففي الأولى ذكر المؤلف حقيقة التجويد، وفي الثانية حكم ترك التجويد، وفي الثالثة أحكام التعوذ والبسملة، وفي الرابعة مخارج الحروف، وفي الخامسة ساق الحديث عن الصَّفات اللازمة، وفي السادسة عن الصفات العارضة، السابعة ذكر أحكام تفخيم لفظ الجلالة وترقيقه، وفي الثامنة أحكام ترقيق الراء وتفخيمها، وفي التاسعة أحكام الميم الساكنة وفي العاشرة أحكام النون الساكنة، والتنوين، والنون المشدّدة، وفي الحادية عشر أحكام المدّ، وفي الثانية عشرة قواعد الهمزة، وفي الثالثة عشرة أحكام الوقف، وفي الرابعة عشر تعرض لمسائل شتى.
أما منهج المؤلّف في الكتاب، فيمكن استخلاصه مما يلي:2
أولا: بدأ المؤلف كتابه بمقدمة بدأها بالحمد والثناء على الله عزَّ وجلَّ- ثم بين فيها أهداف تأليف الكتاب، واسم الكتاب، وأسماء الموضوعات؛ التي تطرق إليها، وذكر أنَّ المواد العلمية؛ التي نثرها فيه؛ إما أن تكون قد أخذها من كتاب؛ فذكر اسم الكتاب، وإما أن تكون من عنده؛ فلم يذكر اسم الكتاب.
ثانيا: يعتني بتعريف المصطلحات المتعلّقة بالأصوات في كثير من الأحيان، ومن أمثلة ذلك قوله في تعريف الهمس: "الهمس: هو صوت لين وخفيف، والحروف، التى توجد فيها هذه الصفة تسمّى مهموسةً، ومفهوم هذه الصفة: أن يتوقف الصوت عند النطق بهذه الحروف بلين ومرونة، يستمر النفس، وينخفض الصوت، ومثل هذه الحروف عشرة مجموعها: (فحته شخص سكت).
وأما الجهر فهو: الإعلان والظهور، والحروف التى توجد فيها هذه الصفة تسمّى ومفهوم هذه الصفة أن يتوقف الصوت عند النطق بهذه الحروف بقوة؛ بحيث ينحبس النفس، ويكون في الصوت نوع من ارتفاع، وجميع الحروف غير المهموسة مجهورة، والجهر والهمس كلاهما صفتان متضادتان".
وقال عند التعريف بالاستعلاء: "الاستعلاء هو الارتفاع والعلو، والحروف؛ التي توجد فيها هذه الصفة تسمّى مستعليةً، ومفهوم هذه الصفة: أن يرتفع أقصى اللسان عند النطق بهذه الحروف إلى الحنك الأعلى، ولأجل هذا تكون هذه الحروف مفخمة، وهذه سبعة حروف؛ مجموعها: خص ضغط قظ.
والاستفال: هو الانخفاض، والحروف التي توجد فيها هذه الصفة تسمّى مستفلةً، ومفهوم هذه الصفة أن لا يرتفع أقصى اللّسان إلى الحنك الأعلى، ولأجل هذا تكون هذه الحروف مرققة، وجميع الحروف سوى المستعلية مستفلة؛ وهذان الاستعلاء والاستفال صفتان متضادتان".
ثالثا: يتناول المؤلّف قضايا وظواهر كثيرةً بالتعليل اللغوي؛ فعندما يتحدث عن مخرج الواو والياء والألف يقول: "المخرج الأول: جوف الفم، يخرج منه الحروف التالية: الواو إذا كانت ساكنةً، وقبلها حرف مضمومٌ كـ الْمَغْضُوبِ"، والياء إذا كانت ساكنة، وقبلها حرف مكسور، كـ"نَسْتَعِين"، والألف غير المهموزة إذا كانت ساكنة، وقبلها فتحة كـ" صِرَاط "؟... والألف والواو والياء؛ التي مر ذكرها- فيما أعلاه- تسمّى حروف المد، والحروف الهوائية، أما الاسم الأول؛ فأطلق عليها؛ لأنها تقبل المد، وستعرف عنها في اللمعة الحادية عشرة، وأمّا الاسم الثاني فأطلق عليها؛ لأنها تخرج مكتملة على الهواء".
رابعا: الإحالة: يحيل المؤلّف المسألة إلى ما يأتي، أو إلى ما مضى، ولا يكررها، ومن أمثلة ذلك قوله عند الحديث عن الراء الساكنة في الوقف: "تفحم الراء وترقّق، بالنظر إلى الحرف قبل الراء عندما تسكن الراء سكونًا تاما؛ كما هو الضابط العام للوقف، ولكن هناك أيضًا - طريقةً أخرى للوقف؛ وهو أنَّ الحرف؛ الذي يوقف عليه، لا يسكن تاما، وإِنَّما تُنطق حركة الحرف نطقا خفيفًا، وهذا ما يسمى روما؛ وهو لا يكون إلا في الكسرة والضَّمَّة، وسيأتي بيانه مفصَّلا في اللمعة الثالثة عشرة - إن شاء الله".
ويقول في اللمعة الثالثة عندما يتحدث عن قواعد النون الساكنة والمشددة: "قد كتبت- في بداية اللمعة الثالثة- أنَّ التنوين يدخل في النون الساكنة؛ فانظر هناك.. القاعدة الأولى: إذا كانت النون مشدّدةً، فلا بد فيها من الغنة، وفي هذه الحالة تسمى حرف الغنة؛ كالميم المشدَّدة، أعِدِ النَّظر في القاعدة الأولى من اللمعة التاسعة. القاعدة الثانية: إذا جاء حرفُ من الحروف الحلقيَّة بعد النون الساكنة والتنوين فلا بد من إظهار في النّون أعد النظر في المخرج الأول، والثاني، والثالث، والرابع من اللمعة الرابعة".
خامسًا: يعتني المؤلف في كثير من الأحيان- بعقد "تنبيه"؛ وذلك أنه يذكر أصولا عامةً، ثم يأتي بالأمثلة توافقها، ثم يعقد تنبيهاً؛ لينبه القارئ أو المتعلم على الأمثلة الخارجة عن تلك الأصول والضوابط العامة، أو ينبه إلى احتمال أمرين بجواز كلّ منهما، ومن أمثلة ذلك قوله في قواعد الراء:
"القاعدة الثالثة: إذا كان الحرف قبل الراء غير متحرك؛ أي: كان ساكنا- وهذا لا يكون إلا في الوقف؛ كما سوف ترى في الأمثلة فانظر إلى ما قبل الحرف الساكن؛ فإن كان مضموما، أو مفتوحا فاقرأ الراء مفحمة، مثل: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَبِكُم الْعُسْرَ؛ حيث إنَّ الرَّاء ساكنة، والدَّال والسين أيضًا- كذلك، والقاف والعين مضمومة؛ لذلك تفحم الراء، وإن كان ما قبل الحرف الساكن مكسورا ترقى الراء؛ مثل " ذي الذكر"، 3 لأنّ الراء والكاف ساكنتان، والذال مكسورة؛ لذلك ترقق الراء. تنبيه أوَّلُ: إذا كان الحرف الساكن قبل الراء الساكنة ياءً؛ فلا ينظر إلى ما قبل هذه الياء، واقرأ الراء مرفقةً على كلّ حالٍ، ولا تبال بحركة قبل الياء؛ مثل: خير، وقدير.
تنبيه ثان: وفقًا للقاعدة الثالثة ترقق الراء في مصر وعَيْنَ الْقِطْرِ عند الوقف، لكنَّ القراء رققوا وموا؛ لذلك يجوز قراءتها بكل من الوجهين، ولكن الأرجح أن تعتبر حركة الراء نفسها؛ فالأولى في القِطْرِ أن تفخّم الراء؛ لأنها مفتوحة، والأولى في مصر، أن ترفّق؛ لأنها مكسورةً.
تنبيه ثالث: وفقا للقاعدة الثالثة تفخم الرَّاء في وَالَّيلِ إِذَا يَسْرِ من سورة الفجر، ولكن بعض القراء رجّح أن ترقّق، ولكن هذه الرواية ضعيفة؛ لذا الأرجح أن تفخّم الراء وفقًا للقاعدة".
خامسا: إذا وُجد خلاف بين العلماء في مسألة ما نجده يرتح ويضعف، وخير مثال على ذلك ما مرَّ آنفًا في التنبيه الثَّالث.
بهذه النماذج من أسلوب المؤلّفين يتضح لنا أن منهج علماء شبه القارة الهندية- في تأليفاتهم في الأصوات- لم يختلف عن مناهج علماء العرب في تأليفاتهم فيها؛ فكما أقبلوا يلبون ثقافتها وحضارتها أقبلوا يأخذون منهجها ومسلكها في التصنيف والتأليف؛ فلا نرى من خلال التعرض لمنهج التأليف عندهم ما يعد من إضافات وزيادات يسبقها علماء العرب، ولا نرى أي اختلاف في منهجهم عنهم.
المصادر والمراجع
1. أسباب حدوث الحروف لابن سينا، تحقيق: محمد حسان الطيان، ويحي مير علم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د.ت.
2. الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس مكتبة نهضة مصر، 1975م.
3. أصول البحث العلمي ومناهجه للدكتور أحمد بدر، وكالة المطبوعات الكويت، 1982م. .
4. الإمام الصغاني، وكتابه (مشارق الأنوار) إعداد: افتخار أحمد بن محمد إسماعيل كاكر، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية (ملتقى أهل الحديث).
5. البحوث الجامعية في الجامعات الهندية حول الأدب العربي للدكتور جمشيد أحمد الندوي، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 1436هـ.
6 .تاريخ فرشته لفرشته ترجمة مولوي محمد فدا علي دار الطبع جامعه عثمانية دكن حيدرآباد، 1932م.
7. التفكير الصوتي عند الخليل للدكتور حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ط1، 1988م.
8. الثقافة الإسلامية في الهند لعبد الحي الحسني، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة ، مصر، 2015م.
9. جمال القرآن لمولانا أشرف علي التهانوي مكتبة البشرى للطباعة والنشر، كراتشي، باكستان، 2011م.
10. الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، د.ت.
.11. الصحاح في اللغة والعلوم، تجديد صحاح العلامة الجوهري في المصطلحات العلمية والفنية للمجامع والجامعات العربية، إعداد نديم مرعشلي، وأسامة مرعشلي، دار الحضارة العربية، بيروت، ط1، 1974م.
12. العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، د.ت.
13. فقه اللسان لكرامت حسين الكنتوري، مطبع نولکشور، لكناو، الهند، 1915م.
14. فوائد مكية لمولانا عبد الرحمن مكي، مكتبة البشرى للطباعة والنشر، كراتشي، باكستان، 2007م.
15. الكتاب لسيبويه، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1988م. .16 المدخل إلى علم اللغة، ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي القاهرة، ط2، 1405هـ.
17. مراتب النحويين لعبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 2009م.
18. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط1، 1412هـ. اللغة لأحمد بن فارس زكري القزويني، تحقيق: عبد السلام هارون،
.19. مقاييس دار الفكر، 1399هـ.
20. مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، 1978م. .
21. نزهة الخواطر لعبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط1، 1420هـ.
22. واقع اللغة العربية في الجامعات الهندية لإرشاد أحمد، المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، 2005م.
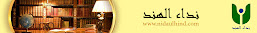

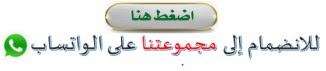
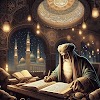







0 تعليقات
أكتُبْ تعليقا