تفاصيل عن المقالة
عنوان المقالة : أبو عطاء السندي (شاعر سندي متعرب في القرن الثامن للميلاد)
الكاتب: الدكتور حافظ غلام مصطفى [1]
ترجمة من الإنجليزية: الأستاذ أبو محفوظ الكريم معصومي[2]
المصدر: مجلة الهند
تصدر عن : مولانا آزاد آئيديل إيجوكيشنال ترست / بولفور، بنغال الغربية
رقم العدد:١
ISSN: 2321-7928
أرقام الصفحات: ٣٥٠-٣٧١
المجلد : ١٠
السنة: ٢٠٢١
الدولة: الهند
تاريخ الإصدار:١ يناير ٢٠٢١
رئيس التحرير: د. أورنكزيب الأعظمي
أبو عطاء السندي مولده ونشأته
أبو عطاء السندي على ما اقتضت هذه النسبة في نفسها كان منحدراً من سلالة سندية؛ هو معدود في شعراء العصر الأموي ولعل معظم مشاهير الكتاب في تاريخ الأدب العربي وفي التراجم والطبقات فوهوا به في مؤلفاتهم وإن نجح مسعاهم قليلا جدًا فيما حدّثونا عن حياة هذا الشاعر وآثاره [3]
نما وترعرع أبو عطاء فيما يظهر في أثناء السنوات الأخيرة للدولة الأموية ولقد عاش بعد أن استحكمت الدولة العباسية نحو خمس وعشرين سنة تماما، ولكنه في أثناء تلك المدة لا يعرف شيء يدلّ على ميادين نشاطه بيد أنه قضى حياته في عزلة إلى أن مات حوالي سنة خمس وسبعين وسبع مائة للميلاد.
شاعريته
كانت الثروة الشعرية لأبي عطاء فيما يجب غنية ضخمة فقد كان شديد الولع بالشعر مع ما أتيح له من مقدرة واسعة على قرض الشعر؛ ولكن لسوء الحظ اتصل بنا اليوم من قريضه قسم يسير جدا. فليس له ديوان شعر فيما انتقل إلينا من التراث العربي القديم وذلك لأحد السببين فإما أنه لم يتفق لأي واحد من الرواة المغرمين بمخضرمي الدولتين أن يدوّنوا شعره في تأليف خاص، وإما اندثر هذا الديوان تماما فلا يرجى بعد أن يرده إلينا الفلك الدوار. ولكن هنالك كتب عديدة تحتوي أشتاتًا من مقطعاته وشوارد أبياته، غير أنّ أصحابها بوجه العموم ينقلون عن بعض الكتب القديمة مادة فيكررون نقلها، ومن هنا لا يكاد يوجد في الكتب المتأخرة شيء يعدّ طريفا قيماً.
لا يزال جزء كبير من بقية الشعر لأبي عطاء مصونًا مودعاً في كتاب الأغاني وبناء على هذا المرجع الأصيل مع ما يضاف إليه من المصادر الأخرى المستخدمة للمراجعة منذ عهد قريب فقط أن تؤلف من شعر صاحبنا الأشتات المبعثرة بترتيب أيضًا وقع حسن وإنما عني بجمعها وتأليفها السيد نبي بخش بلوج السندي فهكذا انحدر ديوان شعر أبي عطاء على صغر حجمه إلى حيز الوجود وظهر إلى النور لأول مرة على صحائف المجلة الربعية الشهيرة، الثقافة الإسلامية الصادرة من حيدرآباد الهند، (المجلد 23، ص: 136-150، تموز 1949م).
هذا العمل الشاق أخذه السيد بلوج على عاتقه بإشارة من الأستاذ والعلامة عبد العزيز الميمني ولا مجال للشك في أنه أفرغ جهده المستطاع في البحث عن شعر هذا الشاعر واقتصاص ما يروى له ويعزى، وهو أيضًا جمع فأوعى قسمًا كبيرًا للمستندات كما هو نفسه يقول: إنني لأجل ألا يزدوج أي مجهود إضافي بهذا الخصوص، تعهدت بهذا العمل أعني التدليل على الشواهد المتوافرة في الحواشي الضافية-- ولكن هذا الديوان لا يزال لسوء الحظ صغيرًا جدًا حتى أن فذلكة الأبيات لم تجاوز مئة بيت وعشرين بيتا ولعل الأرباع الثلاثة منها توجد في كتاب الأغاني وحده.
مهما يكن فإنني أظن أنّ بعض الأبيات يمكن اقتصاص أثره في طوايا المؤلفات الضخمة لكبار العلماء ولا بد لذلك أن نتصفح صحائف هاتيك الكتب من أولها إلى آخرها ولا نتكل على الفهارس الملحقة وحدها ومثال ذلك البيتان اللذان هجا بهما أبو عطاء معاصره الشهير أبا دلامة الشاعر فقد أغفلهما السيد بلوج وهما كما يلي:
ألا أبلغ هُدِيْتَ هدِيتَ أبا دلامة
فليس من الكرام ولا كرامة
إذا لبس العمامة كان قردًا
وخنزيراً إذا وضع كان العمامة[4]
الغرض الذي استهدفه السيد بلوج أن يوعى من شعر أبي عطاء ما تبدو في شتى الكتب ومن هنا لم يتصد للبحث عن حياة الشاعر وعصره وقيمة شعره ببيان حقيق بالاعتبار- ومما يتوضح أن على أساس هذه المادة القليلة لا يمكن لنا أن ندلي إليكم بتحليل كلامه المنظوم بمزيد الإفادة والتفصيل كما لا يمكن أن نقدم أمام العيون صورة كاملة لحياة الشاعر بالاستناد إلى عدة حوادث فقط، ومهما كان فإذا أنعمنا النظر في الشؤون العامة للحركات الاجتماعية والسياسية والأدبية في عصره لما كان مستحيلًا أن نستنجح حتى من هذه البضاعة القليلة جدا بعض نتائج هامة وشيئا ذا بال:
هذا المقال، أرجو من القراء أنهم يعتبرونه فقط مجهودا متواضعا بالنظر إلى نفس الاتجاه الآنف الذكر وليس من الممكن أن نقوم في هذا الصدد بدراسة واسعة مسهبة وكيفما كان فإنما يهمني أن نوضح في هذا الخصوص بعض نقاط هامة وفارقة.
كان اسم أبي عطاء بحسب بعض الروايات[5] "أفلح" على أنّ البعض الأخرى تسميه[6] "مرزوقاً" وإنما سمي أبوه "يسارًا" فيما أجمعوا على ذلك.
وعلاوة على ذلك استطعنا أن نعرف بمراجعة المصادر الأصلية أنّ أبا عطاء ترتى وتهذب بالكوفة ولكن في أي زمان ومكان ولد؟ ولماذا قدم الكوفة وكيف انتقل إليها؟ هذه الأمور كلها لا تزال غير معلومة تماماً وإن كان بعض المراجع المتأخرة تدلّ على أنّ الكوفة نفسها مسقط رأسه ولكن هذا الخبر غير جدير أن يعتد به أو يركن إليه؛ لأنّ المصادر الأصلية التي أحلنا عليها لا تذكر شيئًا يقاربه. وهذا الخبر سيجده الباحث مسطورًا في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان الألماني ولكن لا يمكن له أن يقتص أثر شيء يضاهي هذا الخبر في المراجع المذكورة هنالك[7].
وفي هذا الخصوص ينبغي لنا أن تلقي نلقي نظرة خاطفة على تأريخ الصلات الوثيقة في ذاك العصر بين لغة الضاد وأهليها وبين القطر السندي.
إن العلاقات التجارية بين العرب والسند فيما يبدو ظهرت على مسرح الوجود منذ عهد عهيد نهائيا[8]. والعرب التجار قبل انبلاج فجر الإسلام بحقبة طويلة كانوا يرسون ببعض الموانئ في بلوجستان والسند بأثناء أسفارهم البحرية على طول سواحل البحر العربي وكانوا لوقت ما يقيمون بهذه البلاد السندية ويتعاطون التجارة بمساعدة أهالي السند المواطنين، وكذلك هذا الأمر يعدّ معقولا أنه أمكن لبعض الأشخاص الأشداء أو الأسرات السندية أن يزور أو تزور في وقت من الأوقات العراق أو بلاد العرب ثم أمكن لهذا الطارئ أن يتخذها مستوطناً ثانياً.
وفضلا عن ذلك فكانت هناك مناشئ أخرى أساسية أيضًا للمواصلات المتبادلة فيما بين الشعبين فإن ملوك الفرس منذ حين إلى حين بسطوا أيديهم إلى بعض النواحي السندية واستولوا عليها وحشدوا جحافلهم الجرارة رجالًا مغاوير من طوائف السند الضارية بسفك الدماء كطائفتي الزط والميدا وبعض هؤلاء المحاربين ربما انتهزوا الفرصة للتحول إلى بلاد العراق والعرب ثم إنهم ألقوا بها عصا التسيار فيما بعد.
يجدر بنا أن نتنبه إلى بعض الشواهد أنما ورد في الحديث أنّ الله عبد بن مسعود ذات مرة رأى مع النبي الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم أشخاصًا يمتازون بما لهم من هيئة خاصة وقد وصفهم عبد الله بأنهم تراؤا له كرجال الزط. وذكر البخاري بسنده أنّ عائشة أم المؤمنين اشتكت مرة فاستحضر ابن أختها طبيباً زطيا ليداويها.3 وجاء فيما روى الطبري في تاريخه أنّ علي بن أبي طالب رضي 4 الله عنه لما تولّى الخلافة استخدم لإدارة بيت المال بالبصرة رجالًا من الزط.
بالنظر إلى الأمور الآنفة الذكر ربما لا يُعدّ مخالفًا للعقل أن نقول، ولو بالحدس، إن بعض السنديين هاجروا إلى العراق والقطر العربي حتى قبل أن يتبلج النور الساطع للإسلام أو على الأقل بعيد الإسلام في وقت مبكر جدًا.
أما جدود صاحبنا أبي عطاء فلا نحسب أنهم خرجوا من السند في هذه الأيام المبكرة ولكن يهمّنا بقرب هذه المرحلة أن نذكر نقاطًا عديدة مما يتعلق بهذا الشاعر العربي لغة والسندى جرثومة فلا بد من الانتباه لها:
نقول بادئ ذي بدء أن أبا عطاء تكلم دائماً بلهجة نموذجية لأهل السند ومن هنا لم يقدر قط على أن ينطق بحروف عربية مخصوصة على وجه الضبط الصحيح فكان مثلا كلما تكلم بالعربية تلفظ بالزاى عن الجيم وبالسين عن الشين المعجمة وهلم ولا غرو أنّ هذا النقص المنطقي كان فيما يبدو أمرًا طبيعيا رمى به كل سندي النجاد على الغالب فقد ذكروا كذلك عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو محدث شهير سندي الأصل معاصر لأبي عطاء أنه كان ينطق بالعربية نطقا مغلوطًا فيه فكان مثلا إذا قال: حدثنا محمد بن كعب، نطق بالقاف عن الكاف وهكذا كان الأمر مع مكحول الشامي ، وكان مواطناً أيضًا لأبي عطاء وأكبر منه في السن.
لعل هذه الأمور المتقدمة تكفي للإشارة إلى أنّ صاحبنا أمضى زمن الطفولية في البيئة السندية والتحق بالناطقين بالضاد بعد أن أتقن لغة موطنه الأول بالضبط والدقة وبهذا الخصوص. وينبغي لنا أن نضع نصب عيوننا أنه أولا وقبل كلّ شيء كان عبدًا مملوكًا وقبل أن يتحرر تملك رقبته غير واحد من الموالي واحدًا بعد آخر، وفضلا عن ذلك فإنه كان مطبوعاً على شجاعة جبلية حتى أنه ساهم مساهمة الجد والنشاط في المحاربات الطاحنة بين الأموية والمسودة العباسية.
في ضوء هاتيك الاعتبارات أمكننا أن نحرز بأنه عند ما بدأت السند تفتح على يد القائد الشهير محمد بن القاسم الثقفي فربما اتفق في أثناء ذلك أن سيق أبو عطاء إلى الكوفة في ضمن أسارى الحرب الذين جلبوا إليها ولعله كان إذ ذاك غلاما لم يتجاوز العاشرة وبناء على هذا التقدير يمكن أن نقدر سنّه تماما نحو خمس وسبعين سنة وذلك ما لا يرفضه العقل.
ومهما يكن فإنما استوفى أبو عطاء حظه من التثقيف والتأديب، بالكوفة بين ظهراني العرب إلى أن تأتى له عن ذاك جودة السليقة ونهاية المعرفة بأساليب اللغة العربية وآدابها لا جرم أنه اتصف من جهة الفطرة بقوة العارضة في نظم القريض وبناء على ذلك نجح في تنمية تلك الملكة المودعة فيه في وقت غير طويل حتى أخذ يقرض من الشعر باللغة العربية ما أكسبه الدسائع المتوافرة والجوائز المتكاثرة.
وعند ذلك وقع أبو عطاء فعلًا في ضغطة وارتباك فيقال إنه لما حاز أموالا جمة كجائزة على قصائده إلى أن غني وقنى فهناك ادعى عنبر بن سماك أحد مواليه أنه لا يزال قنا لابن سماك هذا وعندئذ ضاقت الأرض على صاحبنا بما رحبت، وأخيرًا أشار عليه أعوانه المرافقون أن يتصالح مع ابن سماك على شروط يرتضيان بها فصنع عطاء كذلك ووقعت المكاتبة بينهما على أن يؤدي أبو عطاء أربعة آلاف درهم إلى عنبر بن سماك لتحرير رقبته رسمياً- ثم إن خلانه لم يألوا جهدا في جمع هذا المبلغ المحتم ولكن أبا عطاء لم يرض بذلك فارتحل مستقيما إلى حر بن عبد الله القرشي ومدحه بقصيدة زهراء ولعله على هذه القصيدة أصاب من الممدوح ما لا يقدر ذاك المبلغ الخطير فأدى المال إلى عنبر وتحرر حسب الرسوم والنظامات.
والآن إنه نظم مقطوعة يهجو بها عنبر بن سماك، ولحسن الحظ انحدر إلينا من هذه المقطوعة عدة أبيات تمثل أمامنا أنموذجاً ناصعاً للشعر العربي وهي حقيقة أن تتلى عليكم فيما يلي:
إذا ما كنتَ متخذًش خليلا
فلا تثقنْ بكل أخي إخاء
وإن خيرت بينهما فلصق
بأهل العقل منهم والحياء
فإن العقل ليس له إذا ما
تذو كرت الفضائل من كفاء
وإن النوك للأحساب غول
به تأوي إلى داء عياء
فلا تثقن من النوكى بشيء
ولو كانوا بني ماء السماء
كعنبرٍّ الوثيق بناه بيت
ول كن عقله مثل الهباء
وليس بقابل أدبًا فدعه
وكنْ منه بمنقطع الرجاء
ولعل صاحبنا في أثناء هذه الأيام أحس بجد واهتمام أنه لا يسلم من الخطأ في النطق بحروف معينة يمر بها لدى تسميعه وإنشاده القصائد وبسبب ذلك لا يفهم كلامه تماما بل ويضحكون عليه ويهزأون به، هذا من جهة وأما من جهة أخرى فكان أبو عطاء شديد الولوع بالشعر طبعا فما استطاعت هذه العراقيل على كثرتها أن تكبس على غطامط نزعته الشعرية ثم إنه لم يكن قانطًا خائر النفس فما زال يكفر في اختيار خطة تساعده على مجاوزة ذاك الحاجز فصمم على اتخاذ راوية فصيح وينشد بدائع قصيدة وبقصد ذلك نظم أبو عطاء قصيدة مدح بها سليمان بن سليم وهي قصيدة سلسلة سائغة ولكنها في الوقت نفسه عميقة التأثير نهائيا ومليئة بالتحريكة العاطفية ولا بأس بأن نمر ههنا بأبيات عديدة منها فدونكم ما يقول:
أعوزتني الرواة يا ابن سلي
وأبى أن يقيم شعري لساني
وغلى بالذي أجمجم صدري
وجفاني لعجمتي سلطاني
وازدرتني العيون إذ كان لوني
حالكًا مجتوًى من الألوان
فضربت الأمور ظهر ًا لبطن
كيف احتال حيلة للساني
وتمن يت أنني كنت بالشعـ
ر فصيحًا وبان بعض بناني
بعد هذا التمهيد العاطفي الذي لا بد أن يتغلغل في قلب كل رجل مرهف الشعور، تقدم الشاعر إلى أن يعرض حاجياته الماسة على الممدوح بأرفق أسلوب وإنما طلب منه غلامًا طلق اللسان يقدر على إنشاد القصائد بطلاقة وذلاقة وعندئذ أعطاه الممدوح فتًى حدثًا مصقعا وهو ذاك الفتى الذي سماه صاحبنا "عطاء" وتبناه ومن هنا أصبح يعرف بكنية أبي عطاء، ومنذ الآن فصاعدا خدمه هذا الفتى عطاء، كالراوية له فكان أبو عطاء كلما أراد أن ينشد شيئًا من قصيدة في بعض الحفلات ظلّ بنفسه وتقدم راويته عطاء فأنشد القصيدة بالنيابة عن مولاه.
نظم أبو عطاء فيما يبدو شيئًا كثيرًا جدًا في المدائح والتقاريظ وأثنى فيها على مختلف الشخصيات البارزة ولكن اثنين منهم استحقا الذكر بوجه خاص ولعلهما من وأدوم الرجالات الذين شملوا صاحبنا برعاية وعناية بالغتين هما يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق ونصر بن سيار أمير خراسان والمشرق. ولا غرو أنهما جميعا كانا من عظماء الرجال في عصرهما وكلاهما لم يزل حامياً لذمار أبي عطاء ومغدقا عليه بنعم وفيرة وكثيرة فكان أبو عطاء يحسب نفسه في بلاط أي واحد منهما من كما أنه كان في عقر داره وعشيرته- وكان منذ حين إلى آخر ينظم في المديح والثناء عليهما غررا ودرراً. ومما يبدو لنا أنه في أكثر الأحيان لبث بالكوفة مع ابن هبيرة كما أنه شدّ الرحيل مرارا كثيرة إلى نصر بن سيار بخراسان. إنه بقي متشبئاً بأذيال ذينك الأميرين الحفيين به تماما فلم يفارقهما طول حياتهما وكذلك بعد أن اخترمتهما المنية رثاهما ببعض المراثي الجيدة المليئة بما يعرب عن عاطفة ولوعة راسختين في نفسه نحوهما. ومن ثمة بحق تعدّ هاتيك الشذرات المشجية في أروع مقطعات الشعر العربي.
عاش أبو عطاء في ظروف انقسمت بها الهيئة الاجتماعية للمسلمين تماما إلى مختلف الفرق السياسية كالخوارج والعلوية والأموية وهلم جرا وكان كل فرقة تتفانى في العمل لنفسها بجد وحماس بالغين في العراق وخراسان والشام وافتقرت إلى شرذمة من الشعراء بما أنّ الشعر أفاد كل فريق كأجود الوسائل لنشر الآراء وتعميم الدعوة وكذلك لإثارة عواطف الجماهير واستفزازهم بالحزكشة. أما من جهة أخرى فإنّ الشعراء في أنفسهم احتاجوا إلى أن يقوم بتعضيد جانبهم أي ظهير فيحتفل بما أتيح لهم من موهبة شعرية كل محتفل. وذلك لأنهم كانوا لا يملكون شيئًا يغنيهم عن المعايش إلا ما حصل لهم برسم الجوائز والصلات على قصائدهم من عند الأعيان المهتمين بشأنهم كل اهتمام ومن هنا لعل مشاهير الشعراء أجمع كانوا إذ ذاك ينخرطون بميولهم وأهوائهم في سلك أي فريق من هاتيك الفرق المتضاربة المختلفة الآراء في شتى ولايات العالم الإسلامي. فكأن وظيفة الشاعر أن يثني على ذوي الاهتمام بشعره وفنه ثناءً بالغا ويهجو خصوم ممدوحه هجوا مريرا مقذعاً.
عثر جدّ صاحبنا أبي عطاء مع هبوط بني أمية عن حظوظهم السعيدة أنه ما زال ينصر ما يدعم قضيتهم في مجتلد المبارات السياسية المعاصرة وكان ذلك فيما يتوضح غير موافق للتيارات الجارفة وقتذاك فإنّ الموالي أو المعتنقين للإسلام من الشعوب العجمية كانوا بوجه العموم يناوئون الدولة الأموية ورجال هذه الأسرة الحاكمة فقد كان الأمويون فيما رماهم به أعداؤهم منحرفين للغاية عن الحق في تفضيلهم للعرب على العجم فكانوا يعاملون أولئك الرعايا المعتنقين للدين الإسلامي معاملة الإزراء بكل قساوة وما جنحوا قط أن يبوأوا الأعجام والعرب منزلة سواء.
مهما كان فإنا نجد صاحبنا أبا عطاء متحيراً إلى فئة الحماة لبني أمية ويمكن العثور لنا على سبب ذلك في نزوعه إلى الموطن الأول. يقال إن يزيد بن عمر بن هبيرة الذي ولي إمارة العراق كانت أمه من بعض السلالات السندية وعلى ذلك يبدو أنه كيف أحس أبو عطاء بنوع قرابة "سلالية" منه وازداد على الأرجح في توثيق علاقات حارة مع أسرة ابن هبيرة إلى أن وجد نفسه في بلاطه كما أنه كان بين ظهراني عشيرته. وابن هبيرة هذا كان بلا امتراء من رؤس شيعة بني أمية وكبار أنصار البيت الأموي. ومن هنا لم يستطيع أبو عطاء أيضًا إلا أنْ يتحزب للأموية طبعا. وما كان أبو عطاء نصرالأموبين وانتصر لهم بنبوغه في الشعر فقط ولكنه في الواقع حارب عنهم وربما اتفق في بعض هذه المحاربات أنّ أبا عطاء وجد نفسه خلف رجل من بني مرة اسمه أبو يزيد وكان هو أيضًا مع أبي عطاء في الصف فبينما يقتتلان عقر فرس أبي يزيد في معمعة القتال فالتفت هو إلى أبي عطاء وقال له: أعطني فرسك حتى أذود عنك وعن نفسي هلكنا جميعا. وهنالك نزل أبو عطاء عن فرسه وقدمها إلى أبي يزيد المري الذي ما إن ركبها إلا انفلت وحده تاركًا أبا عطاء خلفه مخذولا عديم الحيلة.
حول هذه الحادثة قال أبو عطاء قصيدة فيما بعد ولا تزال عدة أبيات منها توجد للآن: وحسبنا منها أن ننقل البيت التالي فقط الذي ينطوي على حكمة سامية:
رأيت مخيلة فطمع ت فيها
وفي الطمع المذلة للرقاب
ويضاف إلى ذلك أنّ أبا عطاء نصح أيضًا للجمهور أن يظاهروا بني أمية ولا يخالفوهم. وفي عصر مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية قويت شوكة الخوارج تحت قيادة ضحاك الخارجي بحيث إنهم استولوا فعلا على الكوفة وكان ممن تبع الخارجي هذا الله بن عباس الكندي الذي قتل أخوه من قبل على يد ضحاك الخارجي هذا، ومن ثم قال صاحبنا لعبيد الله يحرك فيه مشعر الآنفة:
قل لعبيد الله لو وكان جغفر
هو الحي لم ينجح وأنت قتيل
ولم يتبع المراق والثأر فيهم
وفي كفه عضب الذباب صقيل
إلى معشر أردوا أخاك وأكفروا
أباك فماذا بعد ذاك تقول
ومهما يكن فالمجموعة الباقية من شعره تحتوي أيضًا على قطعة قالها في هجاء بني أمية والظاهر أنه لما سدّت عليه الأبواب كلها بانقراض الدولة الأموية فلم يبق أحد يكفله ضامنًا بمعاشه ومسعفًا بمرامه ولعله في هذه الفترة قاسى أيضًا ضيق اليد فاضطر للخروج من الظروف القاسية إلى البلاط العباسي وبناء على ذلك ورد عنه أنّ العباسية لما استولت على الخلافة فإنه نظم قصيدة في مدحهم وكان هذا المديح غير تام طبعا مالم يكن مقرونا بهجاء أعداء الأسرة العباسية (أي بني أمية خاصة) ولذلك هجا أبو عطاء بني أمية بعد أن كانوا معضدين له بنوع خاص ولعله هجاهم كرها واضطراراً ثم إنه قدم إلى الخليفة العباسي ما قال في مديحه غير أن اتصاله الوثيق ببني أمية كان أشهر من نار على علم فما زال إخلاصه لبني أمية أمرًا مشبوهاً يؤذن له بالدخول على الخليفة في البلاط.
عندئذ، فيما يبدو، تراجع أبو عطاء وقال في هجاء بني العباس مقاطع عديدة والبيت التالي بقية من بعض هذه الأهاجي:
فليت جور بني مروان عاد لنا
ولیت عدل بني العباس في النار
أشرنا من قبل إلى هذه الحقيقة أنّ المسلمين من الجنس العجمى عوملوا في عصر الدولة الأموية كرعايا الطبقة الثانية فما كادوا يستمتعون من الحقوق المدنية نفسها التي استمتع منها مواطنوهم من الجنس العربي فانتهزت العباسية فرصة الانتفاع بهذه الحال ولأجل أن يكتسبوا معونة الرعايا كلهم وعدوا الجمهور بإقامة النصفة الكاملة في المعاملات كلها إما في الحقول الاجتماعية وإما في الحقول السياسية. ومن هنا لقب العباس أنفسهم بحماة العدل ونبزوا الأمويين بالجائرين القساة. والبيت المتقدم هزأ فيه الشاعر بدعوى العباسيين وأعلن بالجهر أنّ عصر الأمويين حتى مع جورهم أكثر توفيقًا من عصر هؤلاء العباسية.
ونفس هذا الرأي أظهره أبو عطاء بوضوح أكثر في قطعة أخرى ومنها ما يلي:
أليس الله يعلم أن قلبي
حب بني أمية ما استطاعا
وما بي أن يكونوا أهلَ عدل
ولكني رأيت الأمر ضاعا
لا غرو أنّ أبا عطاء كان من مشاهير شعراء عصره وكفانا تحقيقا لمكانته البارزة أن نذكر بأن تفوقه في الشعر قد اعترف به الأجلاء من أدباء اللغة العربية الذين امتازوا بعلو مكانتهم في الأدب- يقول الناقد البصير عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت 828 ميلادية): إنه كان بليغا مصقعا. وهذا ابن قتيبة الدينوري (ت 889م) يقول: "كان جيد الشعر". ويبدى البكرى (ت (1093) رأيه فيه بما نصه "وهو مع ذلك من أحسن الناس بديهة وأشدهم عارضة وتقدما - وقال ابن خلكان في مستهل الترجمة لصاحبنا:
"إنه شاعر مشهور، وبعد أن ذكر أخباراً معينة عنه لاحظ بأنه شاعر مجيد، وبعض المقطعات النادرة من شعره توجد في كتاب الحماسة وبذلك انتهت الملاحظة التي قدمها مع بيان ولوعه بشعر أبي عطاء وإنه لو لا مخافة التطويل والخروج عن الموضوع لأورد بعض المقطعات الرائعة له".
في أثناء هذه الأيام التي عاش بها أبو عطاء كانت العراق تزدهر طبعا بوجود عدد وفير للشعراء المفلقين والعلماء المبرزين ولا بد أن أشير على سبيل المثال إلى بشارد بن يرد ومعن بن زائدة الشيباني وأنهما لم يعاصراه فحسب بل قضيا بعض الأحايين في بلاد الأمير ابن هبيرة الذي أكنف أبا عطاء باستدامة فلعله طبعا صحب ذينك الفحلين وأمثالهما وإن لم يصل إلينا بهذه المناسبة شيء جدير بالذكر. وكيفما كان فيبدو أنه لقى من الأدباء المعاصرين له احتراما وتوقيراً فائقين.
يمكن أن نستدل ببعض الأبيات الشاردة لأبي عطاء وبما يدور حولها من الأقاصيص على علاقة وثيقة بينه وبين حماد الراوية الشهير ثم بينه وبين أبي دلامة الشاعر المعروف.
وذلك أنّ حمادًا أوشك مرة أن يقع في أحبولة دبرها بعض حساده بأنه حرش أبا عطاء على أن يهجو حماد الراوية وإنما وقع في مجلس خاص حضراه مع غيرهما فبدأ حماد يهزأ بصاحبنا ويضحك على رطانته إلى أن حمي عليه أبو عطاء فلما أدرك حماد شدة غيظه خاف التبعة فاعتذر إليه على الفور وطلب منه الصفح عما بدر منه. وبمناسبة أخرى تشبه الأولى بالطبع يقول الراوي للقصة إن أهل المجلس كلهم تقريباً كادوا يتقهقهون ضحكا منه بسبب لهجته المغلوطة ولكنهم مع ذلك كانوا خائفين منه حتى لم يتجرؤا على أن يتضاحكوا وإنما أطبقوا الشفاه بكل جهد.
ويروى فيما دار بينه وبين أبي دلامة أنه ذات مرة هجا بغل أبي دلامة فقال:
أبغل أبي دلامة مُتَ هزلًا
عليه بالسخاء تعولينا
دواب الناس تقضم ملمخالي
وأنت مهانة لا تقضمينا
سليه البيع واستعدي عليه
فإنك إن تباعي تسمنينا
فلما بلغ ذلك أبا دلامة خشي أنّ هذا الهجو يتفشى سريعا فباع البغل حالا وهجا بنفسه البغل بكلمة طويلة ولا بأس أن نورد بيتا منها فيما يلي:
فقلت بأربعين فقال أحسنْ
إلي فإن مثلك ذو سجال
هذا وبمناسبة أخرى رأينا أبا عطاء يهجو أبا دلامة هجاء مريرا ولا ندري السبب لذلك غير أنهما لم يكونا إذ ذاك على اتصال ودي وإنما بقي من هذا الهجاء بيتان كما يلي:
ألا أبلغ هديت أبا دلامة
فليس من الكرام ولا كرامة
إذا لبس العمامة كان قردً ا
وخنزيرً ا إذا وضع العمامة
كان أبو دلامة بلا شك شاعرًا معروفا وكان أيضًا شهيرًا لمجونه وسلاطة لسانه وقوة عارضته وارتجاله الشعر ولكنه مع ذلك سكت عن هذه الأهاجي التي قالها أبو عطاء واستسلم لها.
هذه الأحاديث السابقة ترينا رأي العين بأن أبا عطاء احتل مكانة سامقة بين اللواذعة المبرزين من معاصريه وهي أيضًا تشير إلى أنّ قصائده سارت بها الركبان وكانت مألوفة جدا لدى الجماهير، أما سبب هذا الشيوع والانتشار فلعل الباحث يعثر عليه إذا تأمل في شعره من الناحيتين المادية والمعنوية.
مازال الشعر الجاهلي يتخذ نموذجًا أمثل بالعموم حتى في عصر الدولة الأموية والشعراء في الغالب تنافسوا في الامتثال بهذا الشعر في كل من الأساليب والمعاني حتى إذا أثنوا على الخلفاء وأبنائهم الأمراء الذين عاشوا تماما بالعراق أو الشام عيشة متحضرة للدرجة القصوى، أثنوا عليهم بأشياء تعد في خصائص الحياة البدوية كما لو أنهم كانوا متمدحين لبعض شيوخ البدو. ومن هنا لم يستطع الجمهور في مختلف المديريات أن يقدروا قيمة هاتيك المدائح بل أنهم عجزوا أيضًا بالكلية عن فهم مغزاها وذلك لما كانت غالبية الجماهير في شتى الحواضر والأرياف عبارة عن غير الجنس العربي ثم إن العرب المجاورين لهذه الغالبية أيضًا كانوا متأثرين بدرجة عظيمة من الثقافة الأجنبية السائدة.
كيفما كان فإن الأسلوب الذي اختاره أبو عطاء في النظم يبدو ساذجا نقيا للغاية وفي واقع الأمر يبدو بساطة الأسلوب مع الانسجام من معالم شعره الرئيسية. ولا غرو أنه كان شاعر الجماهير كما أنه استعمل اللغة المألوفة لدى العامة انتشرت منظوماته بسرعة فيما بينهم. وكان أبو عطاء نفسه عارفا بما أتيح له من قبول لدى الجمهور وعلى ذلك يقول في غضون مديحه لسليمان بن سليم:
فاعتمدني بالشكر يا ابن سليم
في بلادي وسائر البلدان
ستوافيهم قصائدغرَ
فيك سباقة في كل لسان
فعلًا حظي أبو عطاء بموهوبة فطرية لقرض الشعر، ومن هنا نظم أبياتًا ومقطعات بلا تحضير سالف، وبهذا الخصوص توجد شواهد عديدة تدلّ على أنه استطاع بسهولة جدا أن يرتجل القوافي بأية مناسبة وعلى أي بحر من الموازنين المتنوعة. وربما قدر على أن يكلّم الناس بكلام منظوم وعلى الأرجح كان معروفًا لنظم الشعر ارتجالا فقد طلبوا منه في بعض الأحيان أن يرتجل نظما مقطوعاً على بحر حدوده اختيارا له أو لأي غرض آخر. ومثال ذلك ما ورد في بعض الروايات أنّ إبراهيم بن الأشتر أرسل إليه بالبيتين التاليين واقترح عليه أن يضم إليهما بيتين آخرين على هذا البحر من عند نفسه وهما:
وبلدة يزدهي الجنان طارقها
قطعتها بكناز اللحم معتاطه
وهنا قد حلق النسران أو كربا
وكانت الدلو بالجوزاء منتاطه
ولا شك أنّ هذا البحر عسير جدًا غير أنّ أبا عطاء نظم بمنتهى السهولة بيتين آخرين يلتثمان تمامًا بالتوأمين المتقدمين لا من جهة البحر والقافية فقط بل ومن جهة المعنى أيضاً فقال:
فانجاب عنها قميص الليل فابتكرت
تسير كالفحل تحت ال كور لطَاطة
في أينق كلما حث الحداة لها
بدت مناسمها هوجاء حطَاطة
هذا ولا يستدلن أحد بما تقدّم بيانه أنّ أبا عطاء أتى بشيء من اللهجات المحلية أو العامة المبتذلة المغلوطة نهائياً ولا يخفى أنه استعمل فعلًا لغة بسيطة الجمال منسجمة هي في الوقت نفسه وساذجة وصريحة ولم يستعذب قط لغة مصطنعة وعبارة مكلفة أو الأساليب التقليدية والتراكيب القديمة وكان فعلا قد شرب من روح اللغة العربية فكاد لا يرتكب مخالفة للقواعد اللغوية:
ههنا يمنع تقييد هذا الحارث أنه بينما كان راويته ينشد كلمة له في مدح سليمان بن مجالد، إذ أخطأ في البيت الآتي:
فما فضلت يمينك من يمين
ولا فضلت شمالك من شمال
فإنه تلفظ بكلمتي شمال ويمين مضمومتين فجعلها في حالة الفاعلية وكان ذلك لا محالة خطأ فاحشًا فاهتاج أبو عطاء عندئذ وقال له: "ويلك فما مدهته إذا إنما هزوته" – يريد ويلك فما مدحته إذا إنما هجوته" ثم إنه لقن الراوية هذا البيت على الوجه الصحيح إلا أنه أنشد على الوجه الآتي:
ما فزلت يمينك من يمين
ولا فزلت سمالك من سمال
هكذا أفسد البيت بتمامه لفساد اللهجة والتلفظ السقيم وسبب المستمعين أن يضحكوا عليه ولكنه لم يستطع أن يصبر على غلطة نحوية.
ومهما كان، فإنّ الباحث ربما يعثر على شيء من زلاته في استعمال بعض الكلمات وخاصة في البيت التالي:
دواب الناس تقضم ملمخالي
وأنت مهانة لا تقضمينا
فكلمة (دواب) جمع دابة مشددة الباء ولكن الوزن يقتضي التخفيف وكذلك حرف النون ساقط والأصل (من) (المخالي) ومما يلزم الانتباه له أنّ كلمة (دواب) أو ما جاء على وزنها ما لم يتبدل التخفيف بتشديدها لا يستعمل في أي تفعيل عروضي لأي بحر من بحور الشعر العربي ما عدا التفعيل الأخير للشطر الأول على البحر المتقارب، وبناء ذلك اضطر الشاعر أن يستعمل الكلمة في غير محلها الصحيح بنوع طفيف ويقارب ذلك أنّ الشاعر بخصوص كلمة (من المخالي) تحرر إلى حد ما من المقررات النحوية محافظة على البحر ولعل ذلك يأتي في عداد المرخصات الشعرية ويوجد مثال ذلك في كلام آخرين كثيرين. ولا شك أنّ أبا عطاء أخطأ في البيت التالي:
أقام على الفرات يزيد حولًا
فقال الناس: أيهما الفراتي
وذلك أنّ قافية البيت لا تتفق مع أخواتها الباقية تماما لأن الروي فيها مكسور وأما ههنا فهو مضموم وهذا بلا ريب عيب من عيوب القوافي والعروض، ويسمّى الإقواء. كيفما كان فلا يصح الاستدلال بمثل هذه الأخطاء القليلة على أنّ صاحبنا لم يكن متضلعا باللغة العربية.
أما طرائف معانيه في الشعر فلا يمكن لنا بخصوصها أن نقول شيئًا بالقطع لما أننا نجد قسما قليلًا جدًا من شعره في متناول أيدينا على أنّ هذه البقية اليسيرة من شعره عبارة عن مقاطيع جميلة معينة ومختلف أبيات شاردة وهي تشتمل غالباً على صنوف الشعر المتداولة كلها في عصر الشاعر أعني المديح والهجاء والرثاء والغراميات والوصفيات وهلم جرا. ولكنها لا تكفي للدلالة على كفاءة الشاعر المطردة باعتبار تكفيره الشعري وكيفما كان فإننا نستطيع أن نستنبط من هذه المجموعة اليسيرة بعض النقاط البارزة.
فأولا وقبل كلّ شيء يجب الانتباه إلى أن الشاعر مع أنه فيما يظهر يقتفى بالعموم نماذج تقليدية للشعر الجاهلي لا يكاد يحذو حذوها بالتدقيق والالتزام. فإنه أحيانًا يجترئ فيخلع ربقة الانقياد للقديم ويعرفنا بالتأملات الجدد والآراء المبتكرة. ثم إنه يستمد الهيئة الاجتماعية التي مارسها والشؤون السائدة حواليه في اتخاذ الأشباح الفكرية. ولعله كان رجلًا عملياً ولذلك أحب أن يصف الحقائق المحسوسة للحياة و مشاهدات عينية المليئة بالحيوية ولعل ذلك سبب آخر لشهرته لدى الجماهير ومثال ذلك أنه يقول يهجو العباسية الهاشميين:
بني هاشم عودوا إلى نخلاتكم
فقد قام سعر التمر صاع بدرهم
ونحو ذلك صادف مرة أنّ يزيد بن عمرو بن هبيرة أمير العراق فرق على الناس دسائع ضخمة وهو مقيم بقرب ضفاف الفرات إلا أنه لم يمنح لم يمنح أبا عطاء بنقير ولا قطمير فنظم أبو عطاء بعد ذلك كلمة تحتوي على ما يلي:
أقام على الفرات يزيد حولًا
فقال الناس: أيهما الفراتي
فيا عجبا لبحر بات يسقي
جميع الخلق لم يبْللْ لهاتي
فعند ذلك قال له يزيد: كم يبل لهاتك يا أبا عطاء؟ قال: عشرة آلاف درهم. فأمر يزيد ابنه أن يزن لأبي عطاء هذا المبلغ الخطير. إن القطعة الآنفة تشهد له بالوضوح بقوة الإبداع بالتكفير ولا غرو أنّ هذا الشاعر اتسم خلقة فيما يبدو بعقلية إبداعية ومن هنا كان يجب بالطبع أفكارا جددا وآراء أنه عندما اقتفى أثرًا قديماً لم يقلد القدماء تقليد الأعمى ولكنه حاول على الدوام أن يحدث شيئًا من التصرفات ويأتي بشيء جديد في ضمن ذلك، واتفق ذات مرة في غضون المحادثة أنّ حماد الراوية أنشده البيت الآتي:
إذا كنت في حاجة مرسلا
فأرسل حكيمًا ولا توصه
يبدو هذا البيت حسنًا جدا ولذلك بالعموم يمثلون به ولكن بالنظر إلى الحقيقة ليس هذا المعنى الذي تضمنه البيت شيئًا معمولا به على الدوام إذ ليس بوسع أحد مهما امتاز عقلا وفهما أن يحيط بكل شيء علما و يدعي بذلك كادت هذه النكتة لا تتملص من عقلية أبي عطاء الإجرائية لذلك ما إن سمع صاحبنا هذا البيت إلا وردّ على صاحبه قائلًا: ما أسوأ هذا القول! فقال له حماد: وكيف كنت تقول، فهنالك أجابه أبو عطاء: إنني نقلت هكذا وأنشده ما يأتي على البديهة:
إذا أرسلتَ في أمرٍّ رسولًا
فأفهمه وأرسله أديبا
وإن ضيعت ذاك فلا تلمه
على أن لم يكنْ ع َلم َ الغيوبا
في ضوء التحليل الآنف الذكر لعلني لا أكون مخطئًا إذا قلت إنّ صاحبنا أبا عطاء حقيق بأن يكون معدودًا في طليعة المعرفين ببعض التصرفات القطعية في النموذج القديم للشعر العربي. وسيجد القارئ في هذه المجموعة الضئيلة من شعره أبياتا رائعة يقع عليها الاختيار وبعض المقطعات تحتوي أبياتا تظهر في الواقع كأقوال مليئة جدًا أن أختم هذا المقال بالقطعة الرائعة التالية أوردها صاحب الأغاني في ضمن الأصوات الشيقة لإبراهيم الموصلي (746-804م) أحد مشاهير المغنين العرب على أنه من صغار أقران أبي عطاء أيضًا وهي:
إذا المرء لم يطلب معاشًا لنفسه
شكى الفقر أو لام الصديق فأكثرا
وصار على الأدنين كلا وأوشكت
صلات ذوي القربى له أن تنكر
فسرْه في بلاد الله والتمس الغنى
تعش ذا يسار أو تموت فتعذر
ولا ترض من عيش بدونٍّ ولا تنم
وكيف ينام الليل مَنْ كان معسرا
وما يدرك الحاجات من حيث تبتغى
من الناس إلا من أجد وشمرا
المصادر والمراجع
1. الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري، لايدن، 1913م، د.ط.
2. الأدب المفرد للبخاري، القاهرة، 1375هـ، د.ط. .
3. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (بالألمانية)، د.ت.
4. تاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوري، لبنان، 1951م، د.ط.
5. تاريخ الأدب العربي لنيكلسون، د.ت.
6. تاريخ الرسل والملوك للطبري، طبعة الحسينية، القاهرة .
7. تاريخ الشعر العباسي لأحمد الشائب، القاهرة، 1953م، د.ط.
8. الجامع للترمذي، لكناؤ، 1876م، د.ط.
9. چچ نامه، طبعة دلهي، 1939م، د.ط.
10. دائرة المعارف للبستاني، مصر، 1900م، د.ط.
11. سمط اللآلي للبكري والميمني ، القاهرة، 1936م، د.ط. .
12. الشعر والشعراء لابن قتيبة، القاهرة، 1964م، د.ط.
13. فتوح البلدان للبلاذري، القاهرة، 1323هـ، د.ط.
14. فيليب حتي، تاريخ العرب لفيليب حتي، د.ت. .
15. كتاب الأغاني للأصفهاني، بيروت، 1959م، د.ط.
16. كتاب الكامل للمبرد ، القاهرة، 1355هـ، د.ط.
17. كتاب المعارف لابن قتيبة، غونتجن، 1850م
18. مجلة المورد الفصلية وزارة الثقافة والإعلام، دار الجاحظ، بغداد، المجلد: 9،العدد: 2، صيف 1980م
19. معجم البلدان لياقوت الحموي، بيروت 1957م، د.ط.
20. وفيات الأعيان لابن خلكان، القاهرة، 1948م، د.ط.
الحواشي السفلية
[1] الدكتور الحافظ غلام مصطفى (1919-1993م) ولد في الله آباد، تلقى التعليم الابتدائي على الطريقة النظامية ثم أجاز امتحانات هيأة الامتحانات العربية والفارسية الله آباد. بعد ذلك حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الله آباد كما نال شهادتي ماجستير في اللغة الأردوية وماجستير في اللغة الفارسية من نفس الجامعة، وأما ماجستير في اللغة العربية والدكتوراه فأتمهما من جامعة علي كره الإسلامية بعلي كره. تم تعيينه كأستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة علي كره الإسلامية في 1954م وجُعِلَ أستاذًا مشاركًا فيه في 1961م حتى تقاعد عن مهنة التدريس في 1977م ولم يجعل بروفيسورا لعدم وجود مقعد فارغ لهذا المنصب في القسم. كانت له اليد الطولى على الشعر العربي الكلاسيكي وكان ماهراً بعلم العروض ورجلا صالحاً تقياً. كان يكتب بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأردوية. وله أربعة مؤلفات وهي: "الاتجاهات الدينية في الشعر العربي الجاهلي" (بالإنجليزية) و"إخبار الكرام بأخبار المسجد "الحرام" تحقيق وتعليق) و"ابن الفارض شاعر فريد للشعر العربي الصوفي" و"أدعية قرآنية" (بالأردوية). كانت له علاقة علمية وطيدة العلمية واللغوية للعالم العربي مثل مجمع اللغة العربية بالأردن والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن ومؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي بعمان (الأردن) والجمعية العالمية لإحياء التراث الإسلامي بالقاهرة. وسنفصل عنه ذكراً في مقال مستقل إن شاء الله تعالى. (الأعظمي-أ)
[2] كاتب ومحقق هندي معروف في العالم العربي. له بحوث جليلة بالعربية والأردوية والإنجليزية.
[4] وفيات الأعيان، 77/2 (ترجمة أبي دلامة).
[5] كتاب الأغاني، 245/17
[6] الشعر والشعراء، ص 742
[7] تاريخ الأدب العربي، 63/1
[8] الأخبار الطوال، ص 326، وفتوح البلدان، ص 367
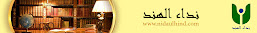

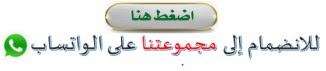







0 تعليقات
أكتُبْ تعليقا